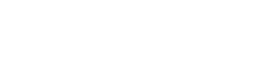محاضرات علوم القرآن - المحاضرة 18
نتابع حديثنا عن القرآن الكريم من حيث علومه وتاريخه وقد بدأنا بالحديث عن القسم الثاني من علوم القرآن وتاريخه ونقصد بذلك ظاهرة الإعجاز القرآني الكريم حيث قلنا أن الإعجاز القرآني الكريم يتمثل في الظواهر المتنوعة إلا أن الظاهرة البلاغية هي التي استأثرت بالاهتمام بصفة أن الإعجاز البلاغي يتوافق والبيئة لاجتماعية التي نزل الإسلام أو تنزل الوحي الكريم خلالها المهم تحدثنا عن هذه الظاهرة وقلنا أننا سنتحدث أيضاً عن الظواهر الأخرى غير أن التركيز سيكون بالنسبة إلى الإعجاز البلاغي وما يرتبط به من مبادئ متنوعة وفي مقدمة ذلك الإعجاز القصصي حيث قلنا أن الإعجاز القصصي أو بالأحرى أن الفن القصصي قد أهمله المحدثون لأن القصة أساساً لم يألفها العرب آنئذ وأن القرآن الكريم بصفته قد احتلت القصة فيه مساحة كبيرة جداً هذا مما يدفعنا إلى أن نعنى بهذا الجانب القصصي وان نوضح للطالب مدى أهمية هذا العنصر وكيفية توظفه في النص القرآني الكريم.
وقد بدأنا في محاضرتنا السابقة بالحديث عن هذا الجانب وقلنا أن القصة هي أنماط متنوعة قد تكون حكاية وقد تكون أقصوصة وقد تكون قصة قصيرة وقد تكون قصة قصيرة طويلة وقد تكون رواية هذا من جانب ومن جانب آخر قد تكون القصة عملاً مكتوباً وقد تكون عملاً مسرحياً هذا بالنسبة إلى القصة بطبيعة الحال.
كما قلنا أن القصة الأرضية الغالب تسلك منحاً خاصاً هو اصطناع أو حادثة واصطناع شخصية تخضع إنما لما هو محتمل السلوك وأحياناً من الممتنع من السلوك وهذا على العكس من القصة القرآنية الكريمة التي تعنى بالواقع فحسب ولا تجنح إلى ما هو ممكن أو ما هو ممتنع كما سنوضح ذلك في حينه إن شاء الله.
المهم أن هذه القصة بأنماطها المتنوعة من جانب وبأشكالها التي اكتسب طابعاً تطورياً من جانب آخر حيث نعرف بأن القصة في الواقع بدأت بما يسمى بالقصة التقليدية أي القصة التي تتم في وجود بداية بها ووسط ونهاية وفي وجود حبكة تنتظمها وهذا ما بدأت به القصة التقليدية إلى نهاية القرن التاسع عشر ومع بداية القرن العشرين شهدت القصة تطورات ملحوظة بدأت بما يسمى بالقصة النفسية التي ظهرت مع مكتشفات علم النفس التحليلي ثم أردفتها القصة الموقفية التي ظهرت خلال ربعي الحرب الأخيرة مع الاتجاه الوجودي ثم القصة المضادة أو الرواية المضادة أو الرواية التي ظهرت بعد ذلك.
وأخيراً القصة التجريبية التي ظهرت في العقود الأخيرة أو في سنواتنا الأخيرة التي يحياها الجيل المعاصر مضافاً إلى أن المسرحية بدورها شهدت تطورات مماثلة وغالبية هذه الأنواع تمردت على الأشكال التقليدية واختطت لها صياغة خاصة ينتسب بعض أهل المنطق النفسي وبعض العبث اللامطلوب والشك...الخ.
المهم عندما نتحدث عن القصة القرآنية الكريمة من خلال مقارنة ذلك بالقصة الأرضية نقول أن القصة الأرضية بتطوراتها التي لاحظتم من جانب وبأشكالها التي لاحظناها سابقاً من جانب آخر نقول مع أن كل هذه الأنماط من التفاوت بين مستويات القصة شكلاً أو تطوراً نقول إننا مع الإقرار بذلك جميعاً نجد ثمة مبادئ عامة تحكم جميع الفن القصصي وهذا الفن سواء أكان تقليدياً أم حديثاً وسواءا أكان نمطاً قصيراً كالحكاية أو نمطاً يتسم الطول كالرواية.
نقول كل ذلك مع ملاحظة التفاوت في هذا الجانب إلا أن ذلك كله لا يحتجزنا من الإشارة إلى أن ثمة مبادئ تمثل مبادئ مشتركة في الفن القصصي نجد أن المقارنة أو التوكأ على هذه المبادئ من جانب ثم المقارنة بين القرآن الكريم في مبادئه القصصية من جانب آخر حيث ننتهي إلى نتيجة هي أن القرآن الكريم قد تمثل فيه نمط من الفن القصصي الذي يتمشى بدوره مع البيئة والتي شهدتها مختلف أجيال القصة ما دام النص القرآني الكريم نصاً إعجازياً نزل في زمن خاص هوزمن البلاغة الموروثة إن ذلك ينسحب مستمراً في مطلق البلاغة وفي مقدمته البلاغة الحديثة ودون أدنى شك البلاغة المستقبلية أيضاً كل ذلك ينسحب على الفن البلاغي في القرآن الكريم ومنه الفن القصصي ولكن مع ملاحظة أن الفن القصصي في القرآن الكريم إذا كان يتعامل مع لغة كل جيل فإن هذا لا يعينه يطابق المبادئ الأربعة بقدر ما يعني انه يطابق ما هو طابع مشترك بينها ولكنه يتميز عنها باستقلالية تامة بحيث يمكن أن نقرر بأن القاص الإسلامي على سبيل المثال إذا أتيح له أن تتوفر على كتابة القصة القرآنية الكريمة حينئذ ينبغي أن لا يقيد نفسه إلى المبادئ الأرضية بشكلها المطلق لأن المبادئ الفرضية لقصة وسواها تحمل دون أدنى شك كثيراً من الأخطاء الفنية فضلاً عن الأخطاء الدلالية وهذا على العكس تماماً من النص القرآني الكريم ومطلق النص الشرعي الذي يتميز بكامله دون أدنى شك من هنا فإن للقرآن الكريم منطقه الخاص في القصة حيث يتميز هذا المنطق من جانب بما هو مشترك بينه وبين المبادئ الأرضية ويتميز من جانب ثان باستقلالية ينبغي أن نأخذها نحن بنظر الاعتبار إذا قدر لنا أن نتأثر بالقرآن الكريم وأن نشيد منه في كتاباتنا الفنية وسواها.
المهم نود أن نشير إلى جملة مبادئ تحكم الفن القصصي وفي مقدمتها الشكل القصصي ولغة هذا الشكل ومن المعروف في ميدان القصة أن اللغة أو الشكل القصصي الذي تكتب به القصة إما أن يكون بالضمير الغائب وإما أن يكون بضمير متكلم وإما أن يكون بضمير المخاطب طبيعياً أن الغالبية من القصص تنتسب إلى النمط الأول ألا وهو القصة المطلوبة بضمير الغائب يليها القصة المكتوبة بالمضير المتكلم ويلي ذلك القصة المكتوبة بضمير المخاطب وإذا كان الأرضيون في تعاملهم مع الفن القصصي يقدمون مسوغات متنوعة لتسويغ هذا الاستخدام للضمير أو ذاك فإن المنطق الإسلامي يتفاوت أو يفترق عن تلك الاتجاهات لأن له منطقه الخاص كما قلنا حيث يظل الموقف هو المحدد أو يظل السياق هو المحدد لهذا النمط من الشكل أو اللغة أو ذلك النمط وبنحو عام يظل القرآن الكريم مكتوباً كما هو في غالبية القص الأرضي مكتوباً بضمير الغائب ولكن هناك بعض النماذج كتبت أو بالأحرى بعض النماذج صيغت بضمير المتكلم ومنها ما صيغ بضمير المخاطب وهو نادر.
وكما قلنا أن الموقف هو الذي يملي ذلك ولذلك فإن الحديث عن أهمية هذا الجانب أو ذاك سوف تظهر فحسب عندما نتحدث عن الضمير الذي انتخبه النص القرآني في شكله القصصي فمثلاً قلنا أن غالبية النص القرآني يكتب بالضمير الغائب ولكن إننا نجد نصاً قرآنياً كريماً يكتب بكامله بضمير المتكلم ألا وهي القصة التي وردت في سورة الجن حيث تبدأ القصة بهذا النحو إنا سمعنا قرآناً عجباً، طبيعياً إن السورة الكريمة تبدأ بقوله تعالى قل أوحي إلي إنه استمع نفر من الجن بعد هذه العبارة التجريدية تبدأ القصة بضمير المتكلم للنحو الذي قرأناه أي قول الجن وهم يتحدثون بضمير المتكلم إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ويستمر هذا الكلام بضمير المتكلم على النحو الآتي وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وهكذا يستمر النص على النحو المتقدم أي النحو الذي يستخدم ضمير المتكلم الجمعي مثل قوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع الخ.
وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وأنا منا الصالحون وأننا ظننا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به الخ.
لاحظوا هذه الضمائر المتتوالية وإنا وأنا الخ. كل ذلك يشكل أسلوباً قصصياً قد استخدم ضمير المتكلم بهذا النحو طبيعياً سوف نشير فيما بعد إلى نمط من اللغة التي تنتسب إلى الحوار حيث نشير إلى أن الحوار أي الكلام الدائر بين طرفين أو أكثر هذا الكلام قد يكون حواراً خارجياً يحدث بين شخصين مثلاً وقد يكون حواراً داخلياً يتحدث به الشخص مع نفسه فحسب وحينئذ عندما يتحدث الشخص مع نفسه يكون الحوار داخلياً تكون صياغة لغته بضمير المتكلم بطبيعة الحال لذلك فهناك خط مشترك بين القصة التي تكتب بضمير المتكلم وبين القصة التي تعتمد الحوار الداخلي.
المهم بغض النظر عن هذه النقطة المشتركة فإن ما يعنينا من ذلك كما نشير بعد حين إن شاء الله إن ما يعنينا من ذلك هو أن نوضح للطالب المسوغ الفني الذي جعل على سبيل المثال أن هذه القصة دون سواها من عشرات القصص تكتب بضمير المتكلم بالنحو الذي قرأناه عليكم.
في هذا السياق يمكننا أن نقول بأن حادثة إسلام الجن تظل حادثة لها أهميتها دون أدنى شك فالقرآن الكريم وقد نزل على البيئة البشرية نجد أن هذه البيئة وقفت حيال الرسالة الإسلامية في البداية مناهضة للشكل التاريخي الذي نعرفه جميعاً وحينئذ حينما نجد أن نمطاً آخر من المخلوقات الكونية أو عضوية أخرى من العضويات المنتسبة إلى الأحياء ألا وهي عضوية الجن حينما نجد أن هذه الطائفة التي لا تنتسب إلى البشر تتجه إلى الرسالة الإسلامية وتقف على العكس تماماً من البيئة البشرية وتقف على العكس تماماً من البيئة البشرية لتؤمن من ثمة رسالة الإسلام مع أن الإسلام نزل بلغة غير لغتهم وببيئة غير بيئتهم وبعضوية غير عضويتهم نقول أن هذا النمط المتميز من الاستجابة حيال الرسالة الإسلامية تتطلب في الواقع عنصراً إقناعياً تاماً وهذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن القصة كفن ينبغي أن يتوفر فيها عنصر الإقناع بشكل ملحوظ وهذا مألوف تماماً في القصة الأرضية ولكن بالنسبة إلى القصة القرآنية التي تتحدث عن الناقع حينئذٍ فإن الأسلوب النفسي الذي تتبعه القصة القرآنية الكريمة في هذا الميدان يظل أمراً فارضاً أهميته التي ينبغي أن نلفت النظر إليها ومن البين أن الإقناع يتحقق لدى القارئ بشكل أكثر فاعلية حينما تترك للشخصية بأن تتحدث هي نفسها عن استجابتنا حيال الرسالة الإسلامية فالقرآن الكريم مثلاً بمقدوره أن ينقل لنا محاورات الجن من حيث الدلالة فيقول مثلاً إن الجن استمعوا إلى القرآن الكريم وآمنوا به بعد أن تحدثوا عن جملة من الموضوعات كان بمقدور القرآن الكريم أن يتحدث بضمير الغائب عن هذا الجانب ولكنه انتخب الضمير المتكلم ليجعل المتلقي أي يجعلنا تحت البشر عندما نستمع إلى المحاورة أو عندما نستمع إلى كلام الجن أنفسهم حينئذ فإن عنصر القناعة سيتوفر بشكل أدق دون أدنى شك وخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الجن وهم غير طائفة البشر إنما تملك لساناً غير لساننا وبيئة غير بيئتنا وعضوية غير عضويتنا حينئذ حينما ندع هؤلاء يتكلمون بأنفسهم بلغتهم ببيئتهم بعضويتهم يكون عنصر الإقناع قد توفر بشكل أكثر مرونة أدنى شك.
وتأكيداً لهذه الحقيقة نجد أن النص القرآني الكريم يحدثنا في سورة أخرى وهي سورة الإحقاف عن ظاهرة إسلام الجن وإيمانهم حتى في هذه السورة الكريمة التي تتحدث عن موضوعات متنوعة ويرد فيها الحديث عن الجن عابراً نقول حتى في هذا النحو العابر من العرض لظاهرة الجن نجده يستخدم نفس ضمير المتكلم حيث يقول أولاً في البداية وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ويبدأ الآن الحديث القصصي بلغة المتكلم الجمعي يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به الخ.
وسنرى أيضاً عند حديثنا عن ظاهرة الحوار وأنماطه ومستوياته كيف النص القرآني الكريم عندما يتحدث عن قصة آدم وسواها وعندما يتعرض إلى الشخصيات المنتسبة إلى الملائكة حينئذ سنجد أنه يحتوي على ترك الشخصيات الملائكية تتحدث أيضاً عن جانب من تجاربهم واستجاباتهم لكي يدلل لنا بأن عنصر الإقناع سوف يتوفر لدى المتلقي أكثر وبشكل أعمق حينما يترك للشخصية بأن تتحدث وفق لغتها طبيعياً هذا لا يعني أن النص القرآني الكريم عندما يوظف شخصيات غير بشرية لا يعني هذا أن هذه الشخصيات يترك له الحديث دواماً ما دامت تختلف عضوية عنا كلا بل كما قلنا أن السياق هو الذي يفرض ذلك الموقف فما دام السياق يرتبط بقضية الاستجابة حيال رسالة الإسلام وضرورة أن يؤمن البشر بهذه الرسالة حينئذ فإن الاستعانة بكلام الجن يوضح بشكل جلي جداً كيف أن الظاهرة الإسلامية تفرض مشروعيتها بحيث يستجاب لها الجن بنحو أفضل من الاستجابة البشرية.
من هنا عندما يتوكأ القصص القرآني الكريم على عنصر أو على عضوية أخرى غير البشر في قصص أخرى حينئذ فإن السياق الذي يحكم تلكم القصص يظل فارضاً نظرته بنحو يختلف عما رأيناه الآن فمثلاً في أقصوصة أو حكاية الفيل أو لنقل فقصة الفيل التي بدأ الحديث عنها بهذا النحو، بسم الله الرحمن الرحيم: (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول) لاحظ أن القصة تتحدث عن طير ألابابيل ترمي بحجارة من سجيل كان من الممكن أن يتحدث النص عن هذه الشخصية التي هي طير ألابابيل كان من الممكن أن يتحدث على لسانها بشكل أو بآخر ولكن النص حاور هذا الجانب بضمير الغائب وسرد ظاهرة الطير الأبابيل الذين وظفهم الله سبحانه وتعالى جنوداً لمحاربة المنحرفين.
إذاً في هذا النص الذي اعتمد مجرد العرض لضمير الغائب بدلاً من ضمير المتكلم أي جعل العرض بلسان النص القرآني نفسه وليس بلسان الشخصية التي استخدمتها القصة كعنصر محارب للمنحرفين وإلا كان بمقدور القرآن الكريم أن يترك لهذه الشخصيات أو لهذه العضوية غير البشرية أن تتحدث عن نمط محاربتها ولكن لا ضرورة لذلك لأن المهم هو أن يوضح القرآن الكريم للمتلقي لأن الله تعالى يقف بالمرصاد لكل من يتعرض للبيت الحرام بسوء ولذلك عندما تعرض للمنحرفون أو بالأحرى عندما حاول المنحرفون الإساءة إلى البيت الحرام أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم جنوداً هي الطير أو هي طير أبابيل بالنحو الذي لاحظناه.
إذاً السياق هنا فرض صياغة القصة بضمير الغائب بالنحو الذي لاحظناه ولا نغفل أيضاً أن القصة في بدايتها تحدثت بلغة المخاطب حيث قالت: (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) حيث أن هذه البداية المتحدثة بلغة الخطاب ثم إثبات ذلك بالعرض الذي يتحدث بلغة الغائب يعني بوضوح أن السياق هو الذي يفرض حيناً هذا النمط من اللغة أو الضمير وحيناً آخر يفرض الآخر وهكذا إذا استخدام اللغة القصصية من خلال ضمير الغائب أو المتكلم أو المخاطب يفرض بالضرورات الفنية أو ضرورات دلالية تجعل من هذا النمط أو ذاك مرهوناً أو موقوفاً على طليعة ما يتطلبه الموقف لكن لندع الآن هذا الجانب ونعني به صياغة القصة بهذه اللغة أو تلك نقول لندع هذا الجانب ولنتحدث في الواقع عن الصياغة القصصية بشكل عام أو من خلال زاوية أخرى وهي زاوية انشطار القصة إلى نمطين من الصياغة الأول السرد والثاني الحوار ونقول بالسرد هو مجرد عرض المظاهرة وأما المقصود بالحوار فنقصد به كما هو واضح المكالمة بين طرفين أو أكثر من طرف فالقرآن الكريم يستخدم هذين النمطين كما هو شائع أيضاً في الدستور القصصي فالقصة الأرضية إما أن تكون سرداً محضاً وإما أن تكون حواراً محضاً وإما أن تكون جامعة بين النمطين وهو ما يسمى غالبية الفن القصصي وأمر يمكننا أن نلاحظه أيضاً بالنسبة إلى القرآن الكريم من حيث قصصه حيث يعتمد القصص الجامعة بين السرد وبين الحوار أكثر مما تتحضر لسرد خالص أو لحوار خالص وبخاصة الحوار الخالص يتحضر بمواقف نادرة ويلي ذلك القصة المفيدة ولعل القصة المسرودة العابرة أو المشيرة إلى هدف ما تظل مكتوبة بلغة السرد المحض لأن الموقف يتطلب ذلك.
كما سنستشهد ببعض الأمثلة في هذا الميدان فبالنسبة إلى السرد الخالص لاحظنا مثلا كيف أن قصة أصحاب الفيل أو كيف أن أقصوصة أصحاب الفيل سردت سرداً خالصاً إلا أن لمسه الفني لهذا السرد يتصل بعملية تذكير قريش والإسلاميين بنعم الله تعالى فبالنسبة إلى قريش النص استهدف تذكيرهم بأن السماء التي أرسلت طيرا أبابيل بمقدورها أن تصنع ذلك حيال قريش العدو الجديد أيضاً بالنسبة إلى الإسلاميين تريد أن تنبئهم بأن السماء التي أبادت العدو القديم بإمكانها أن تبيد العدو الجديد أيضاً فاستدعى ذلك التذكير بعملية سرد مباشر من كلام الله تعالى نظراً لعدم دخول الأتراك في مواجهة مباشرة وأما بالنسبة إلى العرض القائم إلى كل من السرد والحوار فيمكننا أن نقدم أيضاً أقصوصة تتحدث عن حادثتي ابني آدم (عليه السلام) حيث ورد النص على النحو الآتي واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا إذ تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر.
إلى هنا نجد أن هذه الأقصوصة بدأت سرداً ولكن من هذه النقطة يبدأ الحوار على النحو الآتي قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من.. الخ.
فهنا نلاحظ كيف أن كلا من السرد والحوار قد واكب هذه الأقصوصة والمسوغ الفني لهذا التداخل بين كل من السرد والحوار يتمثل بأن ابني آدم الذين تقبل من أحدهما القربان ولم يتقبل من الآخر أنه عارض قضيتهما سرداً يشرح حيثيات القضية وقضية محاور أحدهما لأخيه وهي قائمة على نزعة الحسد التي قلما يستطيع الإنسان أن يكتبها تدفع القاتل إلى تهديد أخيه وبطبيعة الحال لابد أن يدافع عن نفسه وان ينصح أخاه وحينئذ يتطلب الموقف حواراً يرد به الأخ المؤمن على أخيه الكافر وهكذا.
وأما بالنسبة إلى النمط الثالث وهو القصة الحوارية الخالصة أي التي تعتمد الحوار ما بين الطرفين أو بين أكثر من طرفين كي يمكننا أن نستشهد أيضاً بأقصوصة وهي أقصوصة عيسى (عليه السلام) في علاقته مع الحواريين حيث تحدثت القصة عن هذا الجانب على النحو الآتي وهو نحو حواري صرف يقول النص إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنون قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا قال عيسى ابن مريم اللهم انزل علينا مائدة من السماء قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم الخ.
لاحظوا بالنسبة إلى هذه الأقصوصة التي تمت من خلال الحوار الصرف دون أن يتخللها أي سرد نجد أن هذا الحوار أو هذا النمط من الصياغة نجده يقوم بطبيعته على اقتراح تجريبي يتقدم به الحواريون إلى عيسى (عليه السلام) وعيسى لابد أن يرفض أو أن يجيبهم على ذلك الاقتراح ومن ثم في حالة التحفظ حيث قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أو في حالة إجابته لابد أن نتوجه إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى ولابد من السماء أن تجيبه وان تتحفظ السماء في ذلك كل أولئك يتطلب حواراً مع أطراف ثلاثة الحواريين من جانب وعيسى من جانب ثان والسماء من جانب ثالث ما دام الموضوع مرتبطا بعملية ارتباط تجريبي كما قلنا وهذا كله فيما يتصل بالقصص التي تنزع إلى أنماط ثلاثة إما أن تكون حواراً خالصاً وإما أن تكون سرداً خالصاً وإما أن تكون قصة تجمع بين ذلك العنصرين السرد والحوار.
طبيعياً إن لكل من هذين النمطين السرد أو الحوار بلاغته ومبادئه الخاصة وهذا ما سنعرض له الآن عابرا على أن نحدثكم عنه تفصيلاً في محاضرة لاحقة إن شاء الله تعالى قلنا أن لكل من السرد ومن الحوار وكل مبادئه البلاغية التي يتسم بها العنصر القصصي في القرآن الكريم حيث يمكننا بالنسبة إلى السرد أن نعرفه أولا فنقول الرد هو نمط لغوي يتصل بعملية الأخبار عن الشيء بواسطة منشأ القصة كقوله تعالى بالنسبة إلى قصة أهل الكهف حيث يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم فالحديث عن فتية أهل الكهف بما تم من خلال الأخبار بأنهم فتية آمنوا بالله سبحانه وتعالى وزادهم هدى وربط على قلوبهم وأما الحوار فهو العبارة التي تلي السرد المشار إليه مباشرة إذ تقول الآية الكريمة إذ قام فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه احدا...الخ.
إذاً النمط الأول البادئ بقوله تعالى بأنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا هذه الفقرة من الآية الكريمة تعد سرداً بينما الفقرة التي تليها ونعني بها عبارة فقالوا ربنا رب السموات والأرض الخ تعد حوارا كما هو واضح وكل من هذين النمطين ينطوي على أقسام متنوعة من الصياغة الفنية فبالنسبة إلى السرد يمكننا بنحو عام أن نشطره إلى نمطين أحدهما السرد المتصل برسم الظاهرة سواء أكانت هذه الظاهرة شخصية أو كانت شيئاً حيث يتضمن الرسم وصفاً خارجياً لشخصية أو الشيء كقوله تعالى بالنسبة إلى أصحاب الكهف وتحسبهم إيقاظا وهم رقود وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فالملاحظ هنا أن النص يرسم صورة خارجية لهؤلاء الأشخاص وهو قولهم ولكن المشاهد يحسبهم إيقاظا وكونهم يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال وهذا الوصف الخارجي كما تلاحظون مرة قد يتم للشخصيات وأخرى يتم للأشياء أو للبيئة وبالتالي فالنمط الأول ما لاحظناه قبل قليل من حيث الإشارة إلى ابطال هذه الحادثة وهي أننا نحسبهم إيقاظا ولكنهم يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال.
وأما بالنسبة إلى الوصف البيئي أو الوصف الشيء فيمكننا أن نشير إلى العبارة القائلة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين الخ.
فهنا تلاحظون أن الوصف يتصل ببيئة الكهف بحيث صلة هذا الكهف بنمط طلوع الشمس عليه الخ وبطبيعة الحال إن لكل من هذين الوصفين الوصف الحسي للشخصية والوصف المادي للظاهرة أو للشيء أو للبيئة لكل منهما مسوغاته الفنية وليس مجرد عملية وصف فالقارئ من الممكن و هو يطالع القصص الأرضي أي البشري من الممكن أن يلاحظ العمليات الوصفية المثيرة للانتباه والمحققة لإشباع الحس الجمالي لهذه الشخصية إلا أن هذا الوصف الحسي للشيء قد لا تقوم له مواقع قوية بالنسبة إلى الحدث الذي تستهدفه القصة بقدر ما يظل زخرف خارجي لا قيمة له بالقياس ما سوف نلاحظه في القصة القرآنية الكريمة حيث أن لكل وصف علاقة بالسياق الذي ترد القصة خلاله وهو أمر سنحدثكم عنه تفصيلا إن شاء الله في محاضرتنا اللاحقة وهذا فيما يتصل بعنصر الرد من حيث أنماطه ومن حيث مسوغات التي تكمن براءة انتخاب هذا النمط من السرد أي السرد الوصفي من جانب والسرد الإخباري الصرف والمعلوماتي من جانب آخر.
فأما من جانب ثان السرد المتصل بالوصف للشخصية والسرد المتصل للبيئة حيث أن لكل منهما مسوغاته كما قلنا على نحو ما نحدث عنه مفصلاً إن شاء الله تعالى في محاضرة لاحقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.