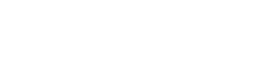محاضرات فقه المجتمع - المحاضرة 40 - في التكاليف السائرة الشخصية العامة للإنسان والبحث فيه في فصلين
المقصد الثاني: في التكاليف السائرة الشخصية العامة للإنسان والبحث فيه في فصلين.
الفصل الأول: في أحكام الأرحام والأقارب
الفصل الثاني: في أحكام الجيران
وسنتعرض إلى أحكام كل من الفصلين بقدر ما يسعه الوقت.
أما الفصل الأول: فهو في الأرحام فقد دلت الأدلة الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، بل العقل في الجملة على وجوب صلة الرحم وحرمة القطيعة فمن الكتاب في صلة الرحم فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى ( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ) وقد ورد في هذه الآية أو ما يقارب هذا المضمون في الآية الشريفة في عدة سور من القرآن ربما تتجاوز الخمسة والستة ولا يخفى أن هذه الآية وصفت أولي الألباب بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل والذي امر الله به أن يوصل هو الرحم كما حذر الكتاب العزيز من قطيعة الرحم كما في قوله تعالى ((وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ)) وفي قوله سبحانه وتعالى ((فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ * أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ)) ومن الواضح إذا كان جزاء العمل هو اللعنة فإنه يدل على شدة الحرمة وفي الروايات الشريفة ما ورد في هذا المعنى أيضاً فعن الصادق (عليه السلام) لما سأله جهن بن حميد (يكون لي القرابة على غير أمري ألهم علي حق قال نعم حق الرحم لا يقطعه شيء فإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان. حق الرحم وحق الإسلام ) .
ويستفاد من هذه الرواية لزوم مراعاة حق الأرحام وإن كانوا من الكفار وعن الرسول الأعظم ( أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كان منه على مسير سنة فإن ذلك من الدين) وشدة التأكيد على صلة الرحم هنا واضحة في متن هذه الرواية وعن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) (صلوا أرحامكم وإن قطعوكم) وعن الإمام الصادق (عليه السلام): (وجدنا في كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار) وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن خمر، ومدمن سحر وقاطع رحم) وسنتعرض بعض الشيء إلى سبب هذه الآثار التي تترب على قطيعة الرحم، وعن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) اقبح المعاصي قطيعة الرحم والعقوق. وعنه (عليه السلام) أيضاً في بيان بعض الجهات العقلية في ضرورة صلة الرحم يقول (أيها الناس انه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عترته ودفاعهم عنه بأيديم وألسنتهم وهم أعظم الناس حيطة من ورائه وألمّهم لشعثه وأعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت به ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يرثه غيره إلا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة أن يسدها بالذي لا يزيده أن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه ومن يقبض يده عن عشيرته فإنه تقبض منه عنهم يد واحدة وتقبض منهم عنه أيد كثيرة ومن تدم حاشيته يستدم من قومه المودة) إلى آخر ما ذكره الإمام (ع).
وكيف كان فإن كل رحم توصل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والمقصود من الرحم ما يبتدأ بعمودي الإنسان من الأب والأم ثم الأجداد وكذا الأولاد والأخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم أيضاً وكل ما ثبت له حق الإرث في الطبقات الثلاثة التي بيناها سابقاً في باب الإرث فإن الرحم ما يتصل إلى الإنسان بنسب وإن بعد وإن كان بعضهم أكد من بعض ذكراً كان أو أنثى خلافاً لبعض العامة حيث قصروه على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم أن كانوا ذكوراً وإناثاً، فمن حرم التناكح بينهم منهم رحم عندهم وأحتج هذا البعض بأن تحريم الأختين إنما كان ما يتضمن من قطيعة الرحم وكذلك الجمع بين العمة والخالة وابن الأخ والأخت مع عدم الرضا مطلقاً الا أن هذا مما يخالف اللغة ويخالف الفهم العرفي من الآيات والروايات. قال تعالى ((فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ)) وقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أن هذه الآية نزلت في بني أمية وقد أورده علي بن إبراهيم في تفسيره أيضاً وهو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحماً كما سميت بنو أمية من الأرحام والظاهر أن صلة الرحم والقطيعة مما ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية وإنما هو مفهوم عرفي يرجع في تحديده إلى العرف ولذا هو يختلف بالعادات وبعد المنازل وقربها والأعراف الاجتماعية من حيث الصلة ومن حيث القطيعة وبنحو مجمل فإن القطع لغة هو الفصل بين الشيئين وأصله يقع في الأجسام ويستعمل في الأعراف تشبيهاً ويكون القطع في الأعراف بالهجران ومنع البر قال تبارك وتعالى: ((وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ)) وقال تعالى ((وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ)) فإن الرحم هو الذي أمر الله به أن يوصل وهؤلاء كانوا يقطعون الرحم ومن الواقع انه حيث لم يرد في الأدلة الخاصة ما يبين معنى الوصل والقطيعة فيحمل على المفهوم العرفي كما إن الوصل هو نقيض الفصل وهو الجمع بين شيئين من غير حاجز ويكون في الماديات كالوصل بين حبلين ويكون في المعنويات كصلة القرابة والرحم كما في مجمع البيان وغيره وعليه فإن المصاديق التي يتحقق بها الوصل والصلة بالأرحام مختلفة فليس له حد يعرف أو محدود وإنما يرجع فيه من ناحية الصلة الأكبر أو الصلة الأدنى إلى العرف فقد ورد عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) (صلوا أرحامكم ولو بالسلام) وفيه تنبيه على أن السلام صلة كما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلوا أرحامكم بالسلام يقول الله تبارك وتعالى ((وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) وعن الإمام الصادق (عليه السلام) (صل رحمك ولو بشربة من ماء وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنه).
ومن الواضح أن هذه قد وردت لبيان المصداق وليس الحصر وإلا فإن الصلة تتحقق بالإنفاق على الأرحام في مساعدة محتاجهم ومعونة فقيرهم والمساهمة في أفراحهم وفي أتراحهم وتليين الجانب لهم وخفض الجناح والسؤال عن أحوالهم وكف الأذى عنهم وحمايتهم في الدفاع عنهم في موارد الحق والنصيحة لهم في موارد الباطل فإن الصلة لا تنحصر في المادة والماديات بل تشمل المعنويات والأمور الاجتماعية والعلاقات العامة أيضاً ولا ريب انه مع فقر بعض الأرحام وهم العمودان تجب الصلة بالمال وتستحب لباقي الأقرباء ويتأكد الاستحباب في الوارد والواجب منه حينئذ هو قدر النفقة وأما في صورة الغنى فتتم الصلة بالهدية في الأعياد بنفسه أو برسوله وأعظم الصلة ما كان بالنفس وبه أخبار كثيرة ثم بدفع الضرر عنها ثم بجلب النفع إليها ثم بصلة من يحب وإن لم يكن رحماً للواصل كزوجة الأب والأخ وأدناها السلام بنفسه أو برسوله والدعاء بظهر الغيب والثناء بالمحضر وقد وردت الروايات بذلك ولا يخفى أن الصلة بعضها واجب وبعضها مستحب أما الواجب فهو ما يخرج به عن القطيعة لأن قطيعة الرحم مصيبة بل قيل هي من الكبائر وأما المستحب فما زاد عن ذلك وقد تظافرت الأخبار بأن صلة الرحم تزيد في العمر فعن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) أن الرجل ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فينسئه الله ثلاثين سنة وإن الرجل ليقطع الرحم وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فيصيره الله إلى ثلاثة أيام. وعنه (صلى الله عليه وآله) (إن القوم ليكونون فجرة ولا يكونون بررة فيصلون أرحامهم فتنمى أموالهم وتطول أعمارهم فكيف إذا كانوا أبراراً بررة) وعنه (صلى الله عليه وآله) (صلة الرحم تهون الحساب وتقي من السوء) وعنه (صلى الله عليه وآله) (صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمال وإن كان أهلها غير أخيار) وعن الإمام الحسين (عليه السلام) (من سره أن ينسأ في أجله ويزداد في رزقه فليصل رحمه) وعن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر) وعن الإمام الباقر (عليه السلام) صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسأ في الأجل) وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا أرحامكم وبروا بإخوانكم ولو بحسن السلام وردّ الجواب) وعن فاطمة الزهراء (عليها السلام) (فرض الله صلة الأرحام منماة للعدد) إلى غير ذلك من الروايات المتظافرة وفي وجه الربط بين صلة الرحم والفوائد المترتبة عليها أو قطع الرحم والأضرار المترتبة عليه كما عرفته من الروايات المتقدمة فيه احتمالات.
الاحتمال الأول: أن يكون هذا من باب الآثار الغيبية فإن العالم لا يجري طبق القوانين الظاهرية والأسباب والمسببات الظاهرية فقط بل هناك أسباب غيبية تدبر شؤون العالم وتكون منشأ الآثار أيضاً لكنها غابت عن أعيننا أو لم يتوصل إليها الإنسان بعد لعجز فيه أو لعجز في العلم الذي لم يتطور بعد كما يلاحظ ذلك في كثير من المعنويات بل وفي كثير من الظواهر المادية التي تحدث ولم يوجد لها تفسير في الأسباب المادية فتفسر بالأسباب الغيبية وهو حق وواقع كما في معالجة كثير من الأمراض أو تحصيل كثير من الرزق أو دفع بعض البلاء أو ما أشبه ذلك.
الاحتمال الثاني: أن يكون هذا من باب الأسباب الخارجية الواقعية حيث أن قطع الرحم يوجب تفكك المجتمع الصالح وإذا تفكك المجتمع الصالح استغل الأشرار نهب الأموال وازداد الخوف والرعب بين الناس وتفشت فيهم الأمراض فقلّت أعمارهم وما أشبه ذلك بخلاف ما إذا كانت صلة الأرحام فإن التواسي والتعاطف والتعاون والمحبة المتبادلة بين الناس يوجب زيادة العمر وزيادة الرزق ونحو ذلك وعليه فإن صلة الأرحام فيها فوائد كما أن قطيعة الرحم تعجل الفناء فإن الأرحام هي اللبنة الثانية في الاجتماع بعد اللبنة الأولى المكونة من الزوجة والأولاد مثلاً فإنه إذا انهدمت لبنات المجتمع ينهدم المجتمع إذ لا تعاون ولا تعاطف ومن الواضح انه إذا تفككت العلاقات الاجتماعية بين الناس يؤول أمرهم إلى الخراب.
الاحتمال الثالث: أن يكون هذا على سبيل الترغيب والحث وليس على سبيل الواقع.
الاحتمال الرابع: أن هذا محمول على الكناية والمجاز فالمراد عن زيادة العمر زيادة البركة فيه يعنى أن من يصل رحمه يجعل الله البركة في عافيته وفي صحته وفي عمره بحيث يتمكن أن ينجز في فترة وجيزة من العمر ما ينجزه طويل العمر أو يشعر بالسعادة واللذة والتوفيقات الإلهية في الدنيا والآخرة بقدر ما يشعر بها من عاش طويلاً ومديداً أو يحمل زيادة العمر بالذكر الحسن بعد الموت لأن الذكر الحسن أحد العمرين لكن الظاهر أن الاحتمال الأول والثاني أقرب إلى فهم الأدلة وأقرب إلى العقل أيضاً ولا داعي لحمل هذه الروايات على المجاز خصوصاً بعد تصريح الكتاب بالزيادة والنقصان في العمر كما في قوله تعالى: ((وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ)) ولا يخفى انه قد ورد في الآيات القرآنية والأخبار المعصومية أن لله تعالى لوحين اثبت فيهما ما يحدث من الكائنات أحدهما هو اللوح المحفوظ الذي لا تغيير فيه أصلاً وهو مطابق لعلم تعالى ولوح المحو والإثبات فيثبت الله سبحانه وتعالى فيه شيئاً ثم يمحوه لحكم ومصالح كثيرة لا تخفى على أولي الألباب مثلاً يكتب فيه أن عمر زيد خمسون سنة ومعناه أن مقتضى الحكمة أن يكون عمره كذا إذا لم يفعل ما يقتضي طوله وقصره فإذا وصل الرحم مثلاً يمحو الخمسين ويكتب مكانه ستين وإذا قطع الرحم يكتب مكانه أربعين بينما في اللوح المحفوظ إنه يصل رحمه وعمره ستون كما أن الطبيب الحاذق إذا اطلع على مزاج شخص يحكم انه عمره بحسب هذا المزاج ستين سنة فإذا شرب سماً ومات أو قتله إنسان فنقص من ذلك واستعمل دواءً طول ذلك فزاد في عمره لم يخالف قول الطبيب والحكمة في وجود اللوح الذي هو للمحو والإثبات وبعد تحقق اللوح المحفوظ يعود إلى مصالح كثيرة ربما نتوصل إلى بعضها وربما لا نتوصل إلى بعضها إلا إن عدم العلم بها أو خفائها علينا لا يدل على عدمها بعد أن دلت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة فإن الله عز وجل حكيم مع انه قد تكون الحكمة أن يظهر للملائكة الكاتبين في اللوح والمطلعين عليه لطفه تعالى بعباده وإيصالهم في الدنيا إلى ما يستحقونه فيزدادوا به معرفة ويمكن أن تكون الحكمة إعلام العباد بواسطة الرسول والحجج عليهم أن لأعمالهم الحسنة في صلاح أمورهم، مثل هذه التأثيرات في زيادة العمر وزيادة الرزق ونحو ذلك كما أن لأعمالهم السيئة تأثيراً في فسادها فيكون داعياً لهم إلى الخيرات صارفاً لهم عن السيئات فيكون لهذا اللوح تقدم على اللوح المحفوظ من جهة لصيرورته سبباً لحصول بعض الأعمال هذا وقد اتفق علماء الكلام على أن القضاء الإلهي ينقسم إلى قسمين القضاء المحتوم والقضاء الموقوف أي المشروط ، والقضاء المحتوم وهو الذي يسمى بالقضاء المبرم يتمثل في أمرين.
الأمر الأول: القضاء الذي اختص به الله تبارك وتعالى فلا يطلع عليه أحد من خلقه والذي أخبر الله به أنبيائه وملائكته انه سوف يقع حتماً وأما القضاء المشروط وهو القضاء الذي أخبر الله أنبياءه وملائكته بأن وقوعه في الخارج موقوف على بعض الأعمال التي يؤديها الإنسان أو موقوف على أن لا تتعلق مشيئة الله تبارك وتعالى بخلافه فيكون وقوعه مشروط بعدم تعلق المشيئة الإلهية أو مشروطاً بفعل الإنسان وعدم فعله وبذلك يظهر أن الروايات التي تدل على وجود الفوائد والمصالح للأعمال والأضرار أيضاً هذا من قبيل القضاء المشروط وليس من قبيل القضاء المحتوم كما أنها مكتوبة في لوح المحو والإثبات لا في اللوح المحفوظ وقد دلت الآيات على وقوع ذلك أيضاً منها قوله سبحانه وتعالى ((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ)) والآية صريحة أن للإنسان أجلين اجل يصل إليه وأجل عند الله تبارك وتعالى. فعن ابن عباس قال قضى أجلاً من مولده إلى وفاته وأجل مسمى عنده من الممات إلى البعث لا يعلم ميقاته أحد سواه فإذا كان الرجل صالحاً واصلاً لرحمه زاد الله في أجل الحياة ونقص من اجل الممات إلى البعث وإذا كان غير صالح ولا واصل نقصه الله من أجل الحياة وزاد في اجل المبعث.
قال وذلك قوله ((وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ)) وكيف كان فالأجل هو الوقت وأجل الحياة هو الوقت الذي يكون فيه الحياة وأجل الموت أو القتل هو الذي يحدث فيه الموت أو القتل وكيف كان فإن للإنسان أجلين أجل مسجل في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير والتبديل وأجل في لوح المحو والإثبات هذا متوقف على القضاء المشروط الذي تتدخل إرادة الإنسان في زيادته ونقيصته بإذن الله سبحانه وتعالى.
وهنا يتضح جهة الصدقة وصلة الأرحام والدعاء والعبادة والمسألة وما أشبه ذلك. فإن ذلك لمدخلية هذه الأعمال في فوائد الإنسان لان القضاء المشروط متوقف على ذلك وقد روى العامة والخاصة الروايات في هذا المجال منها ما رواه الترمذي عن سليمان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر).
وما رواه ابن ماجة عن صفوان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق في خطيئة يعملها وما روي عن ابن عباس أيضاً أن لله لوحاً محفوظاً لله تعالى فيه في كل يوم مائة وستون نظرة يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء). وما روي عنه أيضاً (الكتاب اثنان كتاب يمحو الله ما يشاء فيه وكتاب لا يغير وهو علم الله والقضاء المبرم). إلى غير ذلك من الروايات فضلاً عن ما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) في هذا المجال فضلاً عن الآيات الشريفة التي يفهم منها أيضاً ذلك فلا يرد بعد ذلك إشكال في أن هذه الأعمال كيف يمكن أن تتدخل في زيادة عمر الإنسان إذا كانت صالحة أو تنقص من عمره أو رزقه إذا كانت طالحة. والبحث في هذا طويل ومفصل نرجعه إلى محله فتحصل مما تقدم أن صلة الرحم واجبة على المسلم وقطيعته من الكبائر وإذا كانت صلة الرحم واجبة وقطيعته من الكبائر التي توعد الله عليها النار فينبغي مراعاتها في كل آن ومكان وزمان بلا فرق بين مجتمع ومجتمع وبلد وبلد ويتأكد هذا الوجوب في المجتمعات التي ابتليت بالتفكك الاجتماعي وانشغال الناس بهمومهم الخاصة وبمشاكلهم الشخصية واحتياجاتهم الحيوية واليومية المستمرة بما قد يدعوهم إلى عدم الالتفات إلى أرحامهم وأقاربهم وشيئاً فشيئاً تتفكك الأواصر الأسرية والعلاقات الرحمية بين الناس وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قطيعة الرحم فقال في محكم كتابه الكريم ((فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ * أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ)) وقد قرنت الآية الشريفة الفساد في الأرض بقطيعة الأرحام كما جعلت الجزاء على ذلك اللعنة من الله سبحانه وتعالى والصمم والعمى الذي يصيب أهله من قاطعي الأرحام وقد ورد عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن آبائهم (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إذا أظهر العلم واحتجز العمل اختلفت الألسن واختلفت القلوب وتقاطعت الأرحام أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) ولعل قوله (صلى الله عليه وآله) أصمهم وأعمى أبصارهم إشارة إلى المعنى الحقيقي بمعنى أن الآذان تصم عن سماع ما يرتبط بالأرحام والأقارب من شؤون كما تعمى أبصارهم أيضاً أن ترى ما يعانيه الأقرباء والأرحام من مشاكل ومن معاناة ومن مقاساة وكأنها لا ترى ذلك ويحتمل أن يكون المراد منه المعنىالكنائي. فلعل قوله (صلى الله عليه وآله) أصمهم أي عن سماع ما ينفعهم وأعمى أبصارهم عن رؤية ما ينفعهم وهذان أساس كل بلاء ينصب على المجتمع كما لا يخفى.
وقد ورد عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء قيل وما هي قال قطيعة الرحم) ولا يخفى أن تعجيل الفناء هنا كما يشمل الأمور الشرطية التي تعود على كل إنسان، إنسان لعل المراد منها ما يعود على المجتمع ككل، وقد روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) انه قال في كتاب علي (عليه السلام) ثلاث خصال لا يموت صاحبها أبداً حتى يرى وبالهن البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها وإن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم أن القوم ليكونون فجاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون وان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها) وكيف كان فان قطيعة الرحم محرمة حتى وإن كان ذلك الرحم قاطعاً للصلة تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو مستهيناً ببعض أحكام الدين كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي معه الوعظ والإرشاد والتنبيه شرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتشجيعه على فعل الحرام فلشدة أهمية صلة الرحم لم يقدرها الشرع بإيمان أو بالطاعة أو بالتقوى بل حتى الرحم القاطعة وحتى الرحم الفاسقة بل وحتى الرحم الكافرة على قول يجب صلتها ويحرم قطيعتها ولعل أدنى عمل يقوم به المسلم لصلة أرحامه مع الإمكان والسهولة هو أن يزورهم ويلتقي بهم ويتفقد أمورهم بالسؤال ويشاركهم الأفراح والأحزان ويعود مريضهم وما أشبه ذلك فعن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) (أن أعجل الخير ثواباً صلة الرحم) وعن الحسن بن علي الموسى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لما أسري بي إلى السماء رأيت رحماً متعلقة بالعرش تشكو رحماً لها فقلت كم لك بينها وبينها من أب فقالت نلتقي في أربعين أباً والظاهر أن كلا من موضوع الرحم وحكمه بحرمة القطع ووجوب الوصل أمر عرفي إذ الموضوعات تأخذ من العرف والرواية ذكرت الأربعين من باب المثال وليس الحصر ويتأكد وجوب الصلة وحرمة القطع بين الأرحام إذا كانت الروابط أقرب ، إذا كان هذا الرحم يشكو رحمه إلى الله عز وجل وهم يلتقيان بأربعين أب فكيف به إذا التقى بالأب الواحد أو الأبوين وما أشبه ذلك. ويتفرع على ذلك موضوعان:
الموضوع الأول: في عقوق الوالدين فإن المعقوق الوالدين من اشد أنواع قطيعة الرحم فلا إشكال في حرمة عقوقهما وقد قال تعالى ((وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)) وفي آية أخرى ((قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً...)) وقال الإمام (عليه السلام) (أدنى العقوق أفٍ ولو علم الله عز وجل شيئاً أدون منه لنهى عنه) وقال أبي جعفر (عليه السلام) (قال أن أبي نظر إلى رجل معه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الأب فما كلمه أبي مقتاً حتى فارق الدنيا) وقال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) (من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له) وغير ذلك من الروايات وكيف كان. فإنه لا إشكال في حرمة عقوق الوالدين قال سبحانه وتعالى ((وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)) وفي آية أخرى قال تعالى ((قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً)) وقال تعالى: ((وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً)) إلى غير ذلك من الآيات المباركة كما أن هناك روايات متواترة تدل على ذلك ففي الصحيح عنهم (عليهم السلام) عدّ عقوق الوالدين من الكبائر وفي صحيح عبد الله بن المغيرة عن الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (كن باراً وأقصر على الجنة وإن كنت عقاً فاقصر على النار) إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة ولا يخفى أن الذنب إذا وعد عليه بالنار عدّ من الكبائر كما حققه الفقهاء في محله فكل ما كان عقوقاً كان محرماً كما انه يحرم مخالفة الوالدين بما يوجب إذا هما في غير الواجب العيني كالصلاة مثلاً سواءً كان واجباً بالأصل أو كان كفائياً فأصبح عينياً لعدم قيام من فيه الكفاية وفي الواجب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما لو كان الوالد فاسقاً فيأمر ولده بعدم الصلاة أو عدم الصيام وما أشبه ذلك فإذن في هذه الصورة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا فرق بين الوالدين الكبيرين أو الصغيرين بالسن كما إلا انه لا فرق بين الوالد المسلم والوالد الكافر وقد قال سبحانه وتعالى ((وَوَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)) حيث أن الآية أطلقت لزوم الشكر للوالدين ولم تخصصهما بالإيمان وبالكفر كما أن ذيل الآية الشريفة وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم هذا صريح في أن الوالدين إذا كانا مشركين وأمرا الولد بإطاعتهما أو بالشرك أيضاً أو يترك طاعة الله عز وجل فإنه في هذه الصورة لا تجب الطاعة مما قد يفهم منه بأنه في غير مورد الشرك وفي غير مورد العصيان يجب طاعتهما وسيأتيك مزيد بيان لهذا الموضوع.
الموضوع الثاني: في وجوب الإحسان إلى الوالدين والبر بهما قال سبحانه وتعالى ((وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ)) وظاهر الآية هو الوجوب لكن ذلك يقيد بالمتعارف من الإحسان مما لم تقم السيرة على خلافه فاللازم اتباع سيرة المؤمنين منذ زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كيفية الإحسان إلى الوالدين والى الأقرباء ومن مصاديق البر الشكر للوالدين كما قال سبحانه وتعالى ((أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ)) وفي آيات أخر أيضاً الأمر بشكر الله سبحانه وتعالى والظاهر أن الشكر للوالدين ليس زائداً على سائر الواجبات وترك المحرمات المذكورة في الأدلة الأخر من الأبناء تجاه الآباء. لا انه يلزم أن يقول الإنسان الشكر لله ويعمل الشكر أو يعقد قلبه على الشكر خارجاً عن تلك الأمور الواجبة والاجتناب عن المحرمات. قال سبحانه وتعالى ((اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ)) وقد قال سماحة السيد الشيرازي (دام ظله) في معنى هذه الآية أن المراد بعمل الشكر في مقابل الشكر اللساني كقوله شكراً لله وعقد قلبه بالشكر وعلى أي حال فلم أجد من أوجب ذلك بعنوان مستقل كما أن من مصاديق البر هو خفض الجناح لهما كما قال سبحانه وتعالى ((وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً)) ولا يبعد أن يكون المراد من الآية المباركة الأعم من الواجب والمستحب فإن خفض الجناح بالرحمة للوالدين والدعاء لهم في بعض مصاديقه يكون من الواجبات وفي بعض مصاديقه يكون من المستحبات. نعم استظهر بعض الفقهاء من ذيل الآية أن هذا واجب أخلاقي وليس واجب شرعي وكيف كان فقد وردت الروايات المستفيضة في لزوم بر الوالدين والإحسان إليهما فعن أبي ولاّد الحناط قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل ((وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً)) ما هذا الإحسان فقال (الإحسان أن تحسن صحبتهما وان لا تكلفهما إن يسألاك شيئاً مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنين أليس يقول الله ((لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)) وقال ((إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما)) قال إن أضجراك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن ضرباك قال ((وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً)) قال إن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما فذلك منك قول كريم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل لا تمل عينيك منهما إلا برحمة ورقة ولا ترفع صوتك فوق صوتهما ولا يدك فوق أيديهما ولا تتقدم قدامهما) والظاهر أن قوله ولا يدك بحيث يظهر انك الأعلى منهما ولو من جهة اليد وعن عمار بن حيّان قل خبرت أبا عبد الله (عليه السلام) ببر إسماعيل ابني فقال لقد كنت أحبه وقد ازدرت له حباً. إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتته أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها سرّ بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها ثم أقبل عليها يحدثها ويضحك في وجهها ثم قامت وذهبت فجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها فقيل له يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) صنعت بأخته ما لم تصنع به قال لأنها كانت أبر بوالديها منه، وعن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلاً أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال أوصني قال (ص) لا تشرك بالله شيئاً وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان ووالديك فأطعمهما وبرهما حيين كانا أو ميتين وإن أمراك أن تخرج من أهلك وما لك فافعل فذلك من الإيمان) والظاهر أن قول النبي (صلى الله عليه وآله) وإن أمراك أن تخرج من اهلك أراد بيان الفضل في طاعة الوالدين وهو من باب المجاز لا أنه أراد فعل الولد ذلك حقيقة بأن يطلق زوجته أو يضيع عائلته وما أشبه ذلك وإنما أراد أن يبين أهمية طاعة الوالدين والبر بهما. والظاهر أن وجوب البر والإحسان والطاعة لا يختص بالمؤمنين بل يجب طاعتهما والبر بهما برّين كانا أو فاجرين ففي خبر معمر بن خلاد قلت لأبي الحسن الرضا أدعو لوالديّ إذا كانا لا يعرفان الحق قال ادع لهما وتصدق عنهما وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق وعن عنبسة بن مصعب عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين). ويستحب الزيادة في برّ الأم على بر الأب. فعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أباك والظاهر أن زيادة البر بالأم إما ينشأ من أنها عاطفية وقد خدمت الولد بالحمل والرضاع اكثر من الأب وأما من جهة الحاجة إلى البر اكثر من الأب وهذا لا ينافي الانقياد للأب لأنه عقلاني ولا يبعد التخيير في طاعة أيهما إذا اختلفا على ما احتمله سماحة السيد الشيرازي في الفقه وعن زكريا بن إبراهيم انه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) إني كنت نصرانياً فأسلمت وإن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم؟ قال يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت لا ولا يمسونه. فقال لا بأس فانظر أمك فبرها فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك ثم ذكر انه زاد على برها على ما كان يفعل وهو نصراني فسألته فأخبرها أن الصادق (عليه السلام) أمره فأسلمت فلعل الأمر بالأكل مع الأم كان من باب الأهم والمهم حيث أن الهداية أهم من أكل المتنجس. هذا بناءً على من يرى نجاسة أهل الكتاب. أما على ما ذهب إليه جمع من الفقهاء المتأخرين والمعاصرين من طهارة أهل الكتاب فلا إشكال في ذلك حينئذ وأما قوله (عليه السلام) فلا تكلها إلى غيرك أي تولّ أنت تجهيزها حين الوفاة فلا تقصر في ذلك ولا تتركها إلى غيرك وعن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال موسى (عليه السلام) يا رب أوصني قال أوصيك بك ثلاث مرات قال يا رب أوصني قال أوصيك بأمك مرتين قال يا رب أوصني قال أوصيك بأبيك لأجل ذلك يقال أن للأم ثلثي البر وللأب الثلث ولعل قوله أوصيك بك أي بنفسك من أن تضيعها إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة الدالة على ذلك .