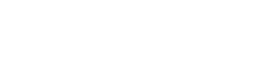محاضرات فقه الدولة - المحاضرة 43
ومن الأخبار الدالة على اعتبار العلم في الحاكم ما رواه في الغرر عن مولانا أمير المؤمنين: (العلماء حكام على الناس) وربما يستفاد من الرواية احتمالات ثلاثة:
- الأول: أن تُحمل الرواية على الإخبار، فيستفاد منها بيان فضل العلم والعلماء وأن العلماء بحسب مقتضى العادة والطبع يحكمون المجتمع والناس يقتدون بهم وذلك لسلطنة العلم وهيمنته على القلوب والأرواح من غير فرق بين المذاهب والملل والشعوب ففي كل مذهب يكون الحاكم على عقولهم وأفكارهم هم العلماء بل لا ينحصر ذلك حتى في مثل علوم الدين أيضاً فتكون لجملة حينئذٍ نظير قوله (عليه السلام): العلم حاكم والمال محكوم عليه، فتدل على قضية خارجية لا علاقة لها بالأحكام فضلاً عن نصب الحاكم.
- الثاني: أن تحمل على الإنشاء فيراد بها حينئذٍ جعل منصب الحكومة والرئاسة للعلماء نظير جعلها للائمة (عليهم السلام) في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): الأئمة من بعدي اثنا عشر ونظير قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تنصيب مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في غدير خم بقوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، بداهة أنها لو حملت على الإخبار فإنه يستلزم المحذور من جهات عدة ولا يسعنا المجال هنا لبيانها.
- الثالث: أن تحمل على الإنشاء أيضاً لكن يراد به التكليف بمعنى إيجاب انتخاب العلماء للحكومة وتعينهم لذلك بحسب حكم الشرع.
وكيف كان فإنه على المحتملين الأخيرين يرتبط الحديث بما نحن فيه وأما على المعنى الأول فلا ربط له به إلا على ما اخترناه في الأصول على أن كل جملة خبرية صدرت عن الشارع تتضمن معنى الإنشاء للقرينة العقلية الكاشفة عن الملاك والغرض المولوي حيث أن العقل يستقل بوجوب بتحقيق غرض المولى فيحكم بوجوبه أيضاً للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
ومن الروايات ما رواه في تحف العقول من قوله (عليه السلام) مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه والحديث في سياقه صدراً وذيلاً يستفاد منه بيان فضل العلم ومشروطيته في مؤهلات الحاكم وشرعية حكومته وعليه فما ورد في منية الطالب وفي حاشية العلامة الأصفهاني على المكاسب من الحمل على الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) لا ينفي ما عداهم وإن كان فيهم أجلى وأظهر هذا وقوة المظلوم واشتهار الحديث رواية وعملاً بين الفقهاء يكفي على المناقشة السندية فضلاَ عما ذكرناه لك سابقاً مما ذكره صاحب تحف العقول في ذكر السند.
ومما يدل على اشتراط العلم والفقاهة في الحاكم أيضاً ما في كتاب سليم بن قيس حيث ورد فيه قوله (عليه السلام) والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة إلى غير ذلك من الروايات المتضافرة المحققة للتواتر الإجمالي أو المعنوي في اشتراط العلم في الحاكم فضلاً عن صحة بعضها.
هذا ولا يخفى عليك وجود روايات كثيرة وردت في مواصفات العمال والموظفين الذين يستعملهم الحاكم وأنه لا ينبغي أن يستعمل إلا من هو أرضى وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه ومنه يستفاد حكم الوالي الأكبر والرئيس الأعلى بطريق أولى إلى غير ذلك ما لا يسعنا المجال لبيانه.
هذا بعض ما ورد من طرق الشيعة وأما من طرق العامة فقد وردت طائفة من الروايات أيضاً منها ما رواه البيهقي بسنده عن ابن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك من هو أعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين وقد روى هذا الخبر عنه العلامة الأميني أيضاً في كتاب الغدير.
ومنها ما في كنز العمال عن حذيفة أيما رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين ومنها ما في كنز العمال أيضاً عن ابن عباس من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وهذا ما صرح به جمع من أعلامهم كما يظهر من كلمات أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وعبد القاهر البغدادي والماوردي وابن خلدون والقلقشندي وغيرهم من أعلامهم مما يكشف عن اتفاقهم على اشتراط العلم في الحاكم وان اختلفوا معنا في معنى العلم والاجتهاد على تفصيل لا يسعنا بيانه هنا.
وكيف كان فإن الظاهر من مجموع الروايات الواردة اعتبار العلم بالكتاب والسنة في الحاكم والرئيس بل يشمل كل سلسلة مراتب الدولة فلو أريد تعيين وزير أو أمير أو وال أو مدير لمنطقة خاصة أو دائرة خاصة وكان هناك فردان متفاوتان في العلم ومتماثلان في سائر الفضائل فلا يجوز تقديم غير الأعلم لما عرفت من الأدلة النقلية والعقلية نعم في صورة التزاحم في الفضائل وعدم إمكان الجمع بينها وعدم قابلية الموضوع لأكثر من واحد يأتي البحث في الأهم منها على حسب ضوابط باب التزاحم.
- الشرط الثالث: من الشروط الترشيحية للحاكم هو الخبروية والكفاءة وربما يعبر عنه في بعض الأخبار بحسن الولاية أيضاً وقد مر عليك في أكثر من مرة أن العقلاء لو أرادوا تفويض أمر من الأمور إلى الغير راعوا فيه بحسب مرتكزاتهم وفطرتهم وجود أمور ومؤهلات في المفوض ولعل من أبرز هذه المؤهلات هي قدرته وقوته على الأمر المفوض إليه وهو ما يعبر عنه بالكفاءة والخبروية والظاهر أنهما وإن اختلفا مفهوماً ولغة لكنهما مصداقاً وعرفاً متحدان أو متساويان لكونهما من قبيل الظرف والجار والمجرور أو من قبيل الفقير والمسكين بمعنى أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا وعليه فإن الخبرة تساوي الكفاءة وبالعكس لكن إذا افترقا فالخبرة تقال بلحاظ العلم والنظر والكفاءة تقال بلحاظ التدبير والعمل.
وكيف كان فإن التتبع في سيرة العقلاء يدلل على مراعاتهم لهذه الضابطة في أمورهم الخاصة والأعمال الجزئية من قبيل إدارة الأعمال والبيع والشراء ونحوها ويذمون من فوض في شؤونه الشخصية غير الكفوء أو أوكلها إلى غير الخبير ويعدونه مقصراً ومستحقاً للوم فتدل على وجوب مراعاة ذلك في الشؤون العامة من إدارة الدولة والحكم بالأولوية القطعية هذا وتتميز كفاءة المرشح للحكم بتوفر جملة من القدرات والمؤهلات فيه لعل منها ما يلي:
منها حسن الإدارة لكون حسن الولاية والكفاءة الإدارية شرطاً أساسياً لتولي مقام الحكومة والرئاسة والواقع التاريخي في سيرة العقلاء قديماً وحديثاً يدلنا على أن تصدي الحكام غير القادرين على الإدارة وغير الأكفاء للولاية جر الشعوب إلى ويلات وويلات بخلاف الأكفاء فإنهم قادوهم إلى المزيد من الإنجازات والانتصارات في مختلف الشؤون.
ومنها دقة الفهم والدراية في الأمور المحيطة به ومن أجل ذلك يتعين على الحاكم الأعلى للدولة أن تبلغ رؤيته السياسية والاجتماعية والاقتصادية درجة يستطيع معها أن يقود الأمة سياسياً واجتماعيا واقتصادياً ويدفع بهم في طريق التقدم في هذه المجالات التي هي عمدة تقدم البلد أو تأخره وهذا يستلزم أن يكون الحاكم ملماً بالأوضاع السياسية وعارفاً بشرائط الزمان وبما يجري على الساحة الدولية من تطورات سياسية واجتماعية لكي يحفظ أمته من كل ما يمكن أن يتوجه إليها من أخطار كما يستثمر القدرات والمواهب التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الأمة والدولة في سبيل التقدم والرفاه.
وفي الخبر عن مولانا الصادق (عليه السلام): العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، وفي الخبر الآخر العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا تزيده سرعة السير من الطريق إلا بعداً، فإن الناس يدور أمرهم بين تسليم زمام الأمور إلى الكفوء أو غير الكفوء ومثل تسليم زمام الحكم لغير الكفوء مثل تسليمها إلى الصبيان للاشتراك في النتيجة مع غير الكفوء وهو أمر معلوم العواقب وقد ورد في الروايات ذم ذلك والإشارة إلى عواقبه الوخيمة كما عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل أي الساعي في الناس بالوشاية ولا يظرف فيه إلا الفاجر حتى قال فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء وإمارة الصبيان. ومن المعلوم أن المراد من قوله (عليه السلام) من إمارة الصبيان هو الإشارة إلى تفويض الأمور إلى من لا يتمتع بالرشد السياسي والخبروية الكافية والبصيرة الإدارية فليس المراد من الصبي المعنى الحقيقي أو الشرعي أي غير البالغ شرعاً بل محمول على المعنى المجازي وهو الجاهل بالأمور وغير المستقل في شؤونه وذلك بقرينة أن الإمام (عليه السلام) في مقام التحدث عن زمن تضيع فيه المقاييس الصحيحة للسياسية والاجتماع فبدلاً من أن تسلم فيه القيادة إلى ذوي الفهم والفكر والكفاءة تسلم إلى غيره وهذه من أعظم المصائب التي تبتلى بها الدول والحكومات ومنها حسن التعامل والتعاطي مع الأمور وهذا ينعكس على أخلاق الحاكم وتصرفاته اليومية بداهة أن الحاكم أسوة وقدوة فتنعكس صفاته الشخصية على أبناء شعبه فإن كان فظاً غليظاً متكبراً عاصياً تعلم منه الناس فينشر العداء بينهم وتضيع الحقوق ويختل النظام وإن كان رحيماً مسالماً عطوفاً متواضعاً انعكست آثاره على المجتمع فكان كذلك مع بعضه ومع ساسته فتتكامل حياتهم وتحفظ حقوقهم وقد ورد في بعض الروايات عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) من نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم وعن مولانا سيد الشهداء (عليه السلام) فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائم بدين الله الحابس نفسه على ذات الله.
ومنها الشجاعة والإقدام وحسن التصميم وقوة الإرادة حتى يتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة في المسائل المهمة ولا يضعف إذ كم من سائس متطلع خبير يضعف عن الإرادة والتصميم لهزيمته النفسية أو ضعفه الروحي وقلة ثباته فيسبب الكثير من المفاسد إلى الدولة وإلى المجتمع.
ومنها سلامة الحواس والأعضاء من السمع والبصر واللسان ونحوها بمقدار ما يرتبط بعمله المفوض إليه أو يوجب عدمه شيناً يسبب نفرة الناس منه وعدم تأثير حكمه فيهم فإن من الواضح أن الحاكم ينبغي أن يكون سليم جسماً وسليماً روحاً وعقلاً لأن التشويه أو النقد في واحدة من هذه الجهات الثلاثة في شخصيته يؤدي إلى نقد الغرض من تنصيبه في هذا المقام.
ومنها استشارة ذوي الرأي والاختصاص لأنه طريق العقلاء في تشخيص الموضوعات الخفية أو المستنبطة دفعاً للضرر المحتمل وأخذاً بأدلة الشورى والاحتياط في الدين واتباعاً للحق والصواب فإن الشورى علامة على كفاءة الحاكم النفسية وأهليته باحترام الآراء ومشاركة الرجال بخلاف المستبد المغرور المتفرد في شؤونه أضف إلى جميع ذلك صفة الحلم فإنه لو كان الشخص جافياً غضوباً قطع الأمة بجفائه وسبب نقض الغرض من الحكم والحكومة.
قال تبارك وتعالى: (فبما رحمة من الله بنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك)، وعن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): آلة الرئاسة سعة الصدر، ولا يخفى عليهم أن المراد بالعلم والاطلاع هنا غير العلم المذكور في الشرط الأول فإن هناك أريد منه الاجتهاد والفقاهة والعلم بالمسائل الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة.
وأما المراد من العلم والخبروية هنا فهو المعرفة الكافية في تقدير الكليات على جزئياتها ومراعات فنون السياسة وحوادث الزمان ومراعاة المصالح والمفاسد في إجراء القوانين وتطبيق القرارات واتخاذ القرار الأصوب في كل مورد من الموارد.
وكيف كان فإنه يدل على اعتبار حسن الولاية الكفاءة والخبروية مضافاً إلى الإجماع والعقل والسيرة العقلائية الكتاب والسنة. فمن الكتاب آيات شريفة منها قوله تبارك وتعالى في قصة طالوت: (إن الله اصطفاه عليكم وزادهم بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم)، وفيها دلالة على أن علة اصطفاء الله عز وجل لطالوت ملكاً هو سلامة جسمه مضافاً إلى علمه كما عرفت مما تقدم وذلك لإمكان أن ينعكس القصور البدني على أعمال الملك فيسبب القصور أو التقصير في حفظ الحقوق وإقامة العدل ومن هنا عمم بعض الفقهاء شرطية سلامة الجسد وحواسه في الحاكم لتشمل حتى غير المعصوم بعد قيام الإجماع على اشتراطه في المعصوم (عليه الصلاة السلام).
وفي بعض التفاسير ورد أن المتبادر من الآية الشريفة أن الله عز وجل فضل طالوت واختاره على الناس بما أودع فيه من الاستعداد الفطري للملك ولا ينافي هذا كون اختياره كان بوحي من الله لأن هذه الأمور هي بيان لأسباب الاختيار وهي أربعة:
1- الاستعداد الفطري.
2- السعة في العلم الذي يكون به التدبير.
3- بسطة الجسم المعبر بها عن صحته وكمال قواه المستلزم ذلك لصحة الفكر على قاعدة العقل السليم في الجسم السليم وللشجاعة والقدرة على المدافعة وللهيبة والوقار.
4- توفيق الله تعالى بإيجاد الأسباب له وهو ما عبر عنه بقوله: (والله يؤتي ملكه من يشاء).
ومن الواضح أن هذه الخصوصيات الأربعة تجمع جوهر الخبروية والكفاءة ومن الآيات قوله سبحانه وتعالى حكاية عن يوسف (عليه الصلاة السلام): (قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) والظاهر إرادة كونه أميناً في حفظ الخزائن والأموال عليماً بفنون حفظها وصرفها في مواردها اللازمة والآية الشريفة ظاهرة في أن الأمانة والعلم هما علة لطلب التلوي على خزائن الأرض فتدل على عدم أهلية من لا يتصف بهما كما أن الظاهر أنهما صفتان متلازمتان لعدم كفاية كل واحد منها لتحقيق الغرض وهذا ما ربما يستفاد أيضاً من مثل قوله سبحانه وتعالى حكاية عن العفريت الذي جاء بعرش بلقيس من صنعاء إلى فلسطين قال: (عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين) الدالة هذه الآية عن قضية ارتكازية في نفوس العقلاء وهي أن الأعمال ينبغي تفويضها إلى القوي الأمين وهذا ما تؤكده الآية الشريفة الأخرى حكاية عن بنت شعيب في حق موسى (عليه السلام) قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين فإذا اشترطت القوة في راعي الغنم بحكم الفطرة والارتكاز فاشتراطها في حاكم الأمة ورئيس الدولة بطريق أولى كما لا يخفى على من تأمل في ذلك هذه بعض الآيات في ذلك.
وأما الروايات فهي متضافرة بل متواترة إجمالاً فضلاً عن تواترها المعنوي منها ما في الكافي بسنده عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. وفي رواية أخرى حتى يكون للرعية كالأب الرحيم وقد مر عليك أن من مظاهر حسن الولاية هو حسن التعامل والشجاعة والمعرفة بفنون السياسية والحلم التي كلها تشكل حقيقة شخصية الحاكم وأهليته في إدارة الأمور وقد مر بعض الروايات الدالة في مضمونها على ذلك أيضاً في شرط العلم.
ومنها ما ورد مضمونه بطرق الفريقين في صحيح مسلم عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبيه ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة أي الولاية وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وقريب من هذا ما أورده العلامة المجلسي (رضوان الله عليه) في البحار عن أمالي الطوسي بسنده عن أبي ذر أن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي إني أراك ضعيفاً لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، مما يكشف أن صدق الحديث والإخلاص في الإيمان والجهاد في سبيل الله وغيرها من صفات كان يتسم بها أبو ذر (رضوان الله عليه) ليست كافية في اختياره كرئيس أو حاكم أو والي يدير شؤون الناس لأن الحكومة تحتاج إلى خبروية وكفاءة خاصة وقد ورد في الغرر عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) من حسنت سياسته وجبت طاعته وفيه أيضاً من أحسن الكفاية استحق الولاية.
والمستفاد من الخبرين الشريفين أن سوء السياسة لا يجيز الطاعة كما أن سوء الكفاية يسقط الأهلية والاستحقاق لهذا المقام لما يترتب عليه من الآثار الوضعية مضافاً إلى الحرمة التكليفية وقد ورد في الكافي عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وإطلاق العلم يشمل الخبرة والكفاءة أيضاً وفي نهج البلاغة فيما كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك في اختيار العمال والجنود ورد فيه تولي من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك وأنقاهم جيباً وأفضلهم حلماً ممن يبطئوا عند الغضب ويستريحوا إلى العذر ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء وممن لا يثيرهم العنف ولا يقعد به الضعف ثم الصق بذوي المروءات أي الأحزاب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة وغير ذلك من صفات.
وهذه في مجموعها تشكل شخصية الحاكم الكفوء الجدير بمقام الرئاسة وفي الدعائم ولي أمر جنودك أفضلهم في نفسك حلماً وأجمعهم للعلم وحسن السياسة وصالح الأخلاق وقريب منه رواه في تحف العقول وقد جاء فيه وأفضلهم حلماً واجمعهم علماً وسياسة.
وفي نهج البلاغة في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مصر حينما ولى عليه الأشتر النخعي (رضوان الله عليه) ورد فيه أما بعد فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع أشد على الكفار من حريق النار وهو مالك ابن الحارث أخو مذحج فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق فإنه سيف من سيوف الله لا كليل الضبة ولا نابي الضربة فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم إلى غير ذلك من الأخبار الدالة في مجموعها على وجوب توفر الحاكم على الكفاءة والخبرة وحسن التدبير والولاية سواء كانت هذه الدلالة مطابقية أو تضمنية أو تلازمية.
ولا يختلف الحال في اشتراط الكفاءة والخبروية بين الرئيس الأعلى وبين مراتب الدولة والحكومة وقد ورد في الإمامة والسياسة أن ابن عباس توسط لنصب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) طلحة والزبير واليين عنه (عليه السلام) في البصرة والكوفة فقال ويحك إن العراقيين بهما الرجال والأموال ومتى تملك رقاب الناس يستميل السفيه بالطمع ويضرب الضعيف بالبلاء ويقوي على القوي بالسلطان ولو كنت مستعملاً أحداً لضره ونفعه لاستعملت معاوية على الشام ولولا ما ظهر لي من حرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي إلى آخر الخبر.
وقد ورد في الأثر كما في منهاج البراعة أنه قد قيل لحكيم ما بال انقراض دولة آل ساسان قال لأنهم استعملوا أصاغر العمال على أعاظم الأعمال فلم يخرجوا من عهدتها واستعملوا أعاظم العمال لأصاغر الأعمال فلم يعثروا عليها فعاد وفاقهم إلى الشتات ونظامهم إلى البتات وعليه فإنه إذا اعتبرت القوة والكفاءة وحسن الولاية في العمال ومراتب الموظفين في الدولة فإنه ينبغي اشتراط ذلك في الحكام والمراتب العليا كما هو واضح.
هذا وهناك صفات أخرى ينبغي توفرها في مرشح الحكومة كشروط ولكن الظاهر أنها إما تعود إلى ما ذكرناه من الشروط الثلاثة أو تعد من الشروط الاستحبابية كالكرم والزهد والعفة والوثاقة والأمانة وما أشبه ذلك من خصوصيات وفضائل أو ما يخالفها من الرذائل كالبخل والطمع والمصانعة وحب الجاه وما أشبه ذلك وهذا ما ورد في طائفة من الروايات منها ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين (عليه الصلاة السلام) أنه قال: إن الله جعلني إماماً لخلقه ففرض علي التقدير في نفسي ومطعمي ومشربي وملبسي كضعفاء الناس كي يقتدي الفقير بفقري ولا يضعني الغني غناه، وعنه (عليه السلام) أيضاً: أن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على لزوم اتسام الحاكم بالمثل والقيم والمعنوية والأخلاقية ليكون كفوءاً ومؤهلاً لهذا المقام هذا بعض ما يرتبط بالشروط التشريحية للحاكم.
وأما الثاني وهو الشروط التنصيبية أي الشروط التي يستحق الحاكم بتوفرها فيه أن يكون رئيساً وحاكماً في الدولة الإسلامية وهي عديدة وأهمها ثلاثة:
- الأول: حيازة الحاكم لرضا الأمة بمعنى أنه يتولى الحكم برضاهم سواء كان بالانتخاب المباشر أو غير المباشر.
- الثاني: أن يأخذ بالشورى في الحكم.
- الثالث: أن يلتزم بتطبيق الإسلام. ولهذا الالتزام مظاهر وعلامات سنتعرض إليها.
- أما الشرط الأول: فقد عرفت تفصيل الكلام فيه فيما تقدم من بحث مسألة الانتخاب وأخذ رضا الأمة.
- وأما الشرط الثاني: وهو الأخذ بالشورى فلا يخفى أن كلامنا يدور عن الحاكم في زمان الغيبة أي في حكومة الفقيه الجامع للشرائط أو من نصبه الفقيه لذلك وليس الكلام عن إمامة النص والحكومة المعصومة كحكومة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) فإن الفقيه الجامع للشرائط أو الحاكم الذي نصبه الفقيه يجب عليه في مقام الحكم وإصدار القرارات أن يأخذ بالشورى وهذا على نحو الوجوب خلافاً لجمع ممن ذهب إلى الاستحقاق ويمكن أن يستدل للوجوب بالأدلة الأربعة.
أما الكتاب فآيتان:
- الأولى: منهما قوله سبحانه وتعالى: (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله) فإنه بعد ظهور لفظ الشورى لغة وعرفاً في تداول الرأي واختيار الأفضل كما ستعرف يمكن تقريب الاستدلال من وجوه:
- أحدها: صيغة الأمر الظاهرة في الوجوب.
- ثانيها: الأمر لكونه في اللغة بمعنى الشأن والقرينة العقلية تقتضي حمله على ما يرتبط بالناس من الشؤون العامة وأهمها شؤون الحكم والسلطة وذلك لأن المحتملات المتصورة في المراد من الأمر بعد صريح الآية الشريفة في توجيه الخطاب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عديدة أبرزها ما يلي:
1- شأن النبوة ومقاماتها التكوينية والتشريعية.
2- شأن الحكم والتكاليف الشرعية.
3- شأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في عادياته كطعامه وشرابه ومنامه ويقظته ورواحه ومجيئه.
4- شأن الناس في أمورهم الخاصة الشخصية.
5- شأن الناس في أمورهم العامة العظيمة.
ولا مجال لحمله على الأولين لكونهما لا يرجعان إلى شورى أو اختيار من الناس بل هي أمور ترجع إلى الله سبحانه بالنص والتعبد كالاحتمال الثاني أو بالإذن والترخيص كالاحتمال الأول وأما لثالث فأمره واضح لقيام الإجماع والعقل فضلاً عن الوجدان بل وهو المستفاد من متضافر الأدلة النقلية على أن عاديات النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) خارجة عن وجوب القدوة والأسوة تخصصاً وكذا الكلام في المحتمل الرابع فلم يبقى إلا الخامس وهو المطلوب وقد وقع الاستعمال للأمر في أكثر من مورد في الروايات الشريفة وأريد منه الحكم والسلطة وغيرها من الشؤون العظيمة للناس.
منها ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
وما عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة، وما عن مولانا الإمام المجتبى الحسن بن علي (عليه السلام) في كتابه إلى معاوية: ولاني المسلمون الأمر بعده، إلى غير ذلك من موارد استعمال كلمة الأمر مما يؤيد أن المتبادر منه بل والمتيقن هو الشؤون العظيمة الكبيرة في الأمة ومن أجلاها وأظهرها هو مسائل السلطة والحكم.
- ثالثها: ذيل الآية الشريفة بقوله سبحانه: (فإذا عزمت فتوكل على الله) للقرينة العقلية وفاء التفريع ومناسبة الحكم والموضوع المقتضية للحمل على العزم بعد المشورة لا قبلها فيثبت الوجوب دون غيره بداهة أن الحمل على غير الوجوب يستلزم المحذور من عدة جهات وذلك لأنه إذا قيل بأن المشاورة ليست بواجبة وإنما دواعي الحكمة تقتضيها من قبيل تطييب خواطر المسلمين وتعليمهم واكتشاف كوامن نفوسهم ونحوها مما ذكر في هذا المجال تقتضي المشاورة على نحو الندب والاستحباب وعليه فإنه يجوز أن يشاورهم (صلى الله عليه وآله وسلم) بل يستحب ذلك ولكن في النتيجة لا يأخذ بحاصل المشورة بل يعزم على مقتضى رأيه المبارك أقول لو حمل العزم على غير الإلزام بعد المشورة فإنه يستلزم لغوياً ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من المشورة من جهة ونقض الغرض منها من جهة ثانية لأنه بعد العزم على ترك رأي الشورى بعد المشاورة والاتفاق عليه والأخذ بما يراه (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه يوجب تنفير الخواطر وتعليم خلافها وانفضاض الناس عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) وإذا قيل بحمل العزم على قبل المشورة فهذا يستلزم لغوية تشريع الأمر بالشورى أيضاً مضافاً إلى المحذورين المتقدمين وحيث أن التوالي الثلاثة باطلة فيتعين الوجوب أي وجوب العزم على الأخذ رأي المشورة بعد الشورى وهذا ما تعضده السيرة أيضاً كما سترى إن شاء الله تبارك وتعالى.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين..