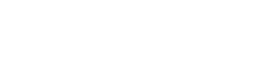محاضرات البلاغة - المحاضرة 31
2- وفيما يتّصل بعرض الموضوعات، تتخذ النصوص الأبنية التالية، حيث تتضمّن:
1- البداية والوسط والنهاية: إن النص الأدبي يشتمل على:
- (بداية) تطرح الموضوع، مثل سورة نوح في بدايتها التي تتحدث عن إرسال الله نوحاً إلى قومه بأن ينذرهم (إنّا أرسلنا... إليهم). ثمّ على:
- (وسط) يوضح الأحداث التي طرحتها البداية، وهو (الإنذار) حيث بدأ نوح بإنذار قومه فعلاً (قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ... إلخ). ثمّ على:
- (نهاية) يختم به الموضوع، وهو غرق القوم (مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا...)... والبداية قد تكون (جزءاً رئيساً) من الموضوع مثل إرسال نوح بأن ينذر قومه، أو تكون (مقدمة) للموضوع مثل سورة الواقعة التي جاءت ذات مقدمة تتحدث عن يوم القيامة (إِذا وَقَعَتِ... إِذا رُجَّتِ الأَرْضُ... إلخ). ثمّ تحدثت عن فئات ثلاث بدأتها بالحديث عن السابقين، ثمّ أصحاب اليمين ثمّ أصحاب الشمال...
2- الإجمال والتفصيل: أي أن كل نص لابد أن يتضمّن بدايته أو بداية مقاطعه طرحاً مجملاً بالنسبة إلى خطوطه العامّة للموضوع ثمّ يبدأ بتفصيله، وهذا مثل تقسيم الناس إلى ثلاث فئات في سورة الواقعة: ثمّ تفصيل الحديث عن كل فئة أو مثل سورة نوح التي أجملت الإنذار أوّلاً (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) ثمّ (فصّلت) الحديث عن مستويات الإنذار (اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ...) (إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً) (وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ) (ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً) (ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ...) إلخ، حيث تفصّل هذه الفقرات مفهوم الإنذار الذي أجملته البداية.
ومن حيث الآليّة التي تنتظم الموضوعات والأهداف، فإن ذلك يتم من خلال:
1-السببيّة: ونقصد به أن الموضوعات تتلاحم فيما بينها من خلال ترتّب أحدها على الآخر على نحو السببية... فقوله تعالى: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ * وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ) فالمصابيح تسبب عنها رجوم الشياطين، وهذه تسبّب عنها عذاب السعير، وهذه تسبّب عنها إلقاء مطلق الكافرين في جهنم، هذه تسبب عنها أن يسمع شهيقها، وأن يشاهد فورانها... إلخ. والسببية نمطان:
1- استمرارية: كالنموذج المتقدم.
2- تمهيدية: وهي أن يمهد الموضوع السابق للاحقه، مثل ما أوضحناه في النموذج الرابع (سورة الصافات).
2- النمو:
ونقصد أن الموضوعات المطروحة في النص تتنامى فيما بينها بمثل ما يتنامى النبات... فقوله تعالى في سورة القلم: (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ... إلخ) يطرح قضيّة (الحلف) ولا تطع كل حلاّف، وقد تطوّر وتنامى الحلف في قضيّة أخرى هي قصّة أصحاب المزرعة الذين حلفوا على منع الفقراء منها بعد وفاة أبيهم (إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ) حيث أن القسم أو الحلف في هذه القصة قد تنامى وتطوّر من قضيّة (الحلف) التي طرحها النص في بداية السورة الكريمة (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ) إلى حلف على منع الفقراء بحيث تسبّب في ضياع مزرعتهم.
3- التجانس:
وهو نمطان:
1- تجانس الموضوعات بعضها مع الآخر. وهو نمطان أيضاً:
1- التجانس في المادة (كالإحياء والإماتة) حيث إن قصصاً متنوّعة في سورة البقرة قد تجانست في المادة المشار إليها.
2- تجانس في الأفكار، مثل سورة الكهف، حيث تفاوتت في مادتها القصصية، ولكنها تجانست في أفكارها (نبذ زينة الحياة الدنيا).
2- التجانس في العناصر: ويقصد به مجانسة كل عناصر النص بعضها مع الآخر، أي: مجانسة الموضوعات والأفكار مع الأدوات الفنيّة في النص، أي (العناصر اللفظية والإيقاعيّة والصوريّة... إلخ) وهذا من نحو ما نجده في سورة (القمر) التي تحدّثت عن قيام الساعة، وإعراض الناس عن الآيات وتكذيبهم ذلك (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ...) ففكرة السورة تقوم على قيام الساعة، وتقديم الآيات، وإعراض الناس عنها، والجزاء المترتّب على ذلك دنيويّاً وأخرويّاً... هذه الفكرة جاءت أدواتها الفنيّة (وهي: العنصر القصصي، العنصر الإيقاعي... إلخ) تتجانس فيما بينها، بحيث وظّفت قصص نوح وهود وصالح ولوط؛ من أجل إنارة المصائر الدنيوية للمكذّبين، كما وظّف العنصر الإيقاعي متمثّلاً في (حرف السين) الذي احتلّ مواقع خاصّة من السورة تتناسب مع مفهوم (قيام الساعة) وما يواكبها من هول... (فالساعة) ذاتها تتضمّن حرف (السين)، والسين هو من حروف الاستقبال (وهو يتناسب مع قيام الساعة التي تقع مستقبلاً) وهو أيضاً يتجانس مع العذاب الأخروي الذي انتخب له النص عبارات تتضمّن حرف (السين) مثل (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَ"سُعُرٍ" * يَوْمَ "يُسْحَبُونَ" فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا "مَسَّ" "سَقَرَ") فـ(سقر) و(سعر) هما من العبارات المجسّدة للنار (حيث ينتخب النص في كل سورة ألفاظاً خاصّة للنار) كما أن عبارات (مس) و(يسحبون) هما من العبارات المجسّدة لعلمية الدخول في النار: عبارة (يسبحون) والوقوع فيها: عبارة (مس)...
إذن: تجانست العناصر الإيقاعية والقصصية واللفظيّة فيما بينها، بنحو ينسجم مع فكرة السورة وموضوعاتها بالنحو الذي لحظناه.
ومن حيث الشكل الخارجي لبناء الموضوعات والأفكار فيمكن تصنيفها وفق الأنماط التالية:
1- البناء الأفقي، 2- البناء الطولي، 3- البناء المقطعي. وهذا الأخير يخذ أشكالاً متنوّعة أيضاً على نحو ما نعرضه لاحقاً.
1- البناء الأفقي:
وهو أن يبدأ النص بطرح موضوع معيّن وينتهي بنفس الموضوع، أي: يأخذ شكلاً أفقيّاً، ومثاله: سورة الواقعة حيث بدأت (بعد مقدمتها) بتصنيف الناس في اليوم الآخر إلى ثلاث فئات: السابقين، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ... وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ... وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ) ثمّ أنهت الموضوع بنفس التقسيم (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ... وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ... وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ...)... طبيعياً، لا يشترط في البناء أن تتفق البداية والنهاية في اللّغة بل يكفي ذلك في المضمون، فالمقرّبون هم نفس السابقين، والمكذّبون هم نفس أصحاب الشمال... ولعلّ هذا الاختلاف في المصطلح ناجم من طبيعة السياق الذي فرض مثل هذا التغيير، فأصحاب اليمين يمثّلون الوسط، وأما السابقون وأصحاب الشمال فيمثّلون طرفي الصعود والنزول، لذلك طرأ تغيير على التسمية بالنسبة إلى هذين القسمين، فالوصف الذي ذكره النص بالنسبة إلى السابقين كان مزدوجاً (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) والسمة الأخيرة ذكرها في النهاية بدلاً من الأولى تأكيداً لمفهوم (التقرب) من الله، وأما سمة (المكذّبين) التي ذكرت في النهاية بدلاً من أصحاب الشمال، فهي من جانب سمة لسلوكهم الذي انتهى بهم إلى أن يكونوا من أصحاب الشمال، ومن جانب آخر: فإن النص عرض سمة التكذيب مفصّلاً في الوسط، مما سوّغ أن تجعل في النهاية سمة تميزهم في هذا الميدان. إذن، جاء التغيير في المصطلح ـ دون المضمون ـ محكوماً بسياقات خاصّة، كما أوضحنا، المهم بعد ذلك أن بناء النص يقوم ـ في هذا النمط ـ على شكل محوري يبدأ من موضع محدّد، ثمّ يقطع رحلة أفقيّة لينتهي بنفس الموضوع؛ كما لحظنا.
2ـ البناء الطولي:
وهو أن يبدأ النص من موضوع محدّد ثمّ ينتهي إلى خاتمته، حسب تسلسله الموضوعي، ومثاله سورة نوح (عليه السلام) حيث بدأت بموضوع محدّد هو: إرسال نوح إلى قومه منذراً، ثمّ انتهى إلى إبادتهم بواسطة الطوفان؛ حيث قطع النص رحلته بشكل طولي دون أن يعود إلى الخط الذي انطلق منه؛ حيث بدأ نوح بالإنذار وألحّ على ذلك ولكنّهم أمضوا في الغواية ووضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصرّوا واستكبروا... وقالوا: لا تذرنّ آلهتنا.. إلخ، مما ترتّب على ذلك أن يكتسحهم الطوفان.
إذن، جاء البناء الفني لهذه الحادثة طوليّاً يأخذ خطوطه حسب تسلسل الوقائع؛ كما لحظنا، بينا كان الشكل السابق (البناء الأفقي) يأخذ خطوطه حسب تسلسل الموقف أيضاً، لكنّ العود إلى بداية الخط.
3- البناء المقطعي:
وهو أن يطرح النص جملة من الموضوعات، ثمّ يقف عند نهاية أو بداية كل موضوع (كل مقطع) فيجعله رابطاً بين الموضوعات، ومثاله سورة المرسلات حيث ينتهي كل موضوع أو مقطع بآية تتكرّر في جميع لمقاطع وهي (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) على هذا النحو:
(وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً * فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً * وَالنَّاشِراتِ نَشْراً... وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ).
(أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ * ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ * كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ).
(أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ * فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ * إِلى قَدَرٍ... وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ).
(أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفاتاً * أَحْياءً وَأَمْواتاً... وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ...).
(انْطَلِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ... وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ...).
(هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ... وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ...).
فالسورة تقوم ـ كما لحظنا ـ على مقاطع: كل واحد منها يختم بعبارة (ويلٌ...) حيث تقطع الرحلة بشكل مقطعي مقابل الشكلين السابقين اللذين يقوم أحدهما بقطع الرحلة أفقيّاً والآخر طوليّاً...
والبناء الأخير (أي المقطعي) يأخذ أشكالاً متنوّعة من البناء:
1- الشكل الذي لحظناه: حيث يختم المقطع بعبارة خاصة.
2- الشكل الذي يبدأ بعبارة خاصّة ويختم بعبارة أخرى خاصّة، ومثاله سورة القمر الذي يبدأ كل مقطع منها بعبارة (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ...) وتختم بعبارة (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ).
ويلاحظ أيضاً أن العبارة المقطعيّة سواء أكانت في البداية أم النهاية لا تأخذ شكلاً ثابتاً بل تضاف إليها عبارة جديدة أو أكثر، فسورة القمر ذاتها ختم مقطعها الأوّل عن قوم نوح بالعبارات الثلاث: (1- وَلَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ * 2- فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ * 3- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) بينما ختم مقطعها الثاني (قوم عاد) بالآيتين الأخيرتين (2- فكيف...) و(3- ولقد يسرنا..) وجاء المقطع الثالث بالعبارة (2- فكيف...) وحدها، ثمّ جاء المقطع الرابع بالعبارة (3) وحدها وجاء المقطع الخامس بالعبارتين (2 و3)...
3- الشكل الذي يتوسّط مقطعه أيضاً عبارة خاصّة وليس بداية المقطع ونهايته فحسب، ومثاله سورة الشعراء، حيث يتوسّط كل مقطع فيها عبارة (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) مضافاً إلى بدء كل واحد منها بعبارة (كذّبت...) وختامه بعبارة (إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَةً..).
وهناك أشكال أخرى من البناء المقطعي الذي يتكرّر في مقاطعه بداية أو وسطاً أو نهاية عبارة خاصّة أو يزاد عليها أو ينقص منها شيء أو تحذف حيناً، حسب السياق الذي يفرض مثل هذه الزيادة أو النقصان أو الحذف، عرضنا لجانب منها عند حديثنا عن عنصر (التكرار) في النص الأدبي، فيما لا حاجة إلى إعادة الكلام فيها.