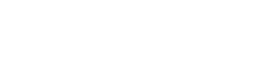محاضرات البلاغة - المحاضرة 30 - العنصر البنائي
العنصر البنائي
المقصود من العنصر البنائي هو: العمارة التي يقوم النص الأدبي عليها بصفته مجموعة من الأفكار والموضوعات التي تخضع لتخطيط خاص في صياغتها، من حيث ارتباط كل جزء منها بالآخر، أي ارتباط من أوّل النص ووسطه ونهايته بعضها مع الآخر، وارتباط كل موضوع بما سبقه ولحقه من الموضوعات، ثمّ تجانس العناصر اللفظيّة والإيقاعيّة والصورية وتجانسها مع الموضوعات والأفكار المشار إليها... وهذا يعني أنّ النص الأدبي هو (وحدة) فنيّة تنتظمها مجموعة من الموضوعات والأساليب، تخضع لهيكل خاص من الصياغة...
وهذا ما نعتزم تفصيل الحديث عنه ضمن عنوان:
وحدة النص الأدبي:
النص الأدبي هو: (كما سبق القول في الفصول المتقدّمة):
1- مجموعة من (الموضوعات) التي تتضمّن فكرة أو (هدفاً)... فسورة (الفيل) مثلاً (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ) تتضمّن (موضوعاً) هو: حادثة أصحاب الفيل، وتتضمّن (فكرة) أو هدفاً هو: أنّ الله تعالى يقف بالمرصاد لكلّ من يحاول إلحاق الأذى بالبيت الحرام.
2- هذه الموضوعات والأهداف تشتمل على فروع أو أجزاء أو أقسام، فآية (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ) هي (جزء) من الموضوع، وآية (أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ) هي: (جزء) آخر من الموضوع، وهكذا سائر الآيات التي تضمّنتها السورة الكريمة.
3- هذه الأجزاء أو الأقسام، مرتّبة وفق تخطيط هندسي بحيث إذا غيّرنا مكان واحد منها ووضعناه مكان الآخر، أو حذفناه أو قدّمنا أو أخّرنا بعضاً منها عن الآخر، يحدث (خلل) في موضوع الحادثة وفكرتها.
4- هذا يعني أن هذه (الأجزاء) أو (الأقسام) مترابطة فيما بينها، كل واحد منها يتناسق مع الآخر، بحيث تفضي بمجموعها إلى تحقيق الغرض الفكري الذي تستهدفه السورة من وراء عرضها لحادثة أصحاب الفيل.
5- يترتّب على ذلك أن نقول: بأن النص الأدبي هو (وحدة) فكريّة أو موضوعيّة، تتضمّن (أجزاء) متناسقة فيما بينها، بحيث تصبّ هذه (الأجزاء) في (الوحدة) المشار إليها.
6- يترتّب على ذلك أن نقول أيضاً: أنّ كل (جزء) لا يمكن أن ننظر إليه منفصلاً عن علاقته بـ(الأجزاء) الأخرى، وعلاقة هذه الأجزاء جميعاً بـ(وحدة) الفكرة والموضوع، لأن النظر إلى كل جزء على حدة، يجعل النص فاقداً وحدته الفكرية والموضوعيّة التي يستهدفها.
7- يمكننا (من أجل الدراسة فحسب) أن نفصل (الجزء) عن (وحدة) النص، ولكن بشرط أن نربطه بعد ذلك بوحدة النص؛ كما لو تناولنا ـ في سورة الفيل ـ الآية الأخيرة التي تتضمّن (تشبيه) أصحاب الفيل بالعصف المأكول؛ من حيث المصائر التي انتهوا إليها، ففي هذه الحالة نتحدّث عن أهمية هذا التشبيه (ونكون بذلك قد فصلناه عن هيكل النص) لكننا بعد ذلك نربطه بالهيكل المذكور لنحافظ على وحدة النص، بصفة أن هذا التشبيه لم يجئ منفصلاً عن السياق الذي وردت فيه حادثة أصحاب الفيل.
8- إن وحدة النص قد تتمثل في طرح موضوع واحد تتلاحم أجزاؤه، وقد تتمثل في طرح موضوعات مختلفة فتتلاحم الموضوعات فيما بينها.
9- إنّ وحدة النص لااً مِنْ عُمُرِه الموضوعات وأجزائها بعضاً مع الآخر، بل تتجاوز إلى سائر أدوات الفن التي استخدمها النص مثل: عنصر الإيقاع والصورة، والقصة... إلخ، بحيث يتناسق الإيقاع مع طبيعة الموضوع، وتوظّف الصورة من أجل إنارة الموضوع، وتسرد القصّة لتلقي ظلاًّ على الموضوع، وهكذا، بالنحو إلي سنعرض له لاحقاً. لكن في حالة التعدد ينبغي إخضاع جميع الموضوعات لفكرة واحدة. فسورة (أرأيت) مثلاً (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ * فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) هذه السورة تتضمن موضوعين، أحدهما (الذي يكذّب بالدين) والآخر: المصلّي الذي يسهو عن صلاته، إلاّ أن الموضوعين قد جمع بينهما هدف فكري واحد هو قضيّة عدم الإنفاق في سبيل الله، فالكافر: يمتنع عن العطاء، فينهر اليتيم ولا يطعم الفقراء ولا يحضّ على ذلك، والساهي عن صلاته: يمتنع عن العطاء أيضاً، فيمنع زكاته أو قرضه أو متاعه عن الآخرين...
مسوّغات الوحدة:
لحظنا أن النص الأدبي، يظلّ بمثابة عمارة أو جسم أو جهاز صناعي، يحتلّ كل جزء منه وظيفة خاصّة، وترتبط هذه الأجزاء بعضها مع الآخر بحيث إذا اختلّ واحد منها ترك تأثيره على سائر الأجزاء، ودخل التشويه وفقد جماليّته، كما لو اختلّت وظيفة أحد أجهزة الجسم (الدورة الدمويّة مثلاً) أو أصابته عاهة (العرج مثلاً) أو نقص (قطع أحد اليدين مثلاً) أو قبح بنحو عام (عدم تناسق أعضاء الوجه مثلاً) فإذا كان النص الأدبي مطروحاً بشكل عشوائي، فإن الغرض الفكري الذي يستهدفه النص، سوف لن يتحقّق بالشكل المطلوب، لأنّ إدراكنا للشيء (ومنه: النص الأدبي) يعتمد على التأثير (الكلّي) الذي يتركه هذا النص لدى القارئ. فإذا أصاب النص خلل؛ ترك تأثيره على إدراكنا لمفهوم النص. والسر في ذلك، أن الكون نفسه خاضع لنظام خاص يتألّف من جزئيّات يتناسق بعضها مع الآخر ضمن (الكل) أو (الوحدة) التي تنتظم هذه الجزئيّات، ومنها: عمليّة الإدراك للشيء، حيث أن عمليّاتنا الذهنية أو إدراكنا للشيء لا يتم عشوائياً بل يتم وفق إدراك لـ(الكل) الذي يضمّ جزئيّات نلحظها بنحو غير منفصل عن (الكل) الذي ينتظمها، فأنت حين تقرأ صفحة من الكتاب أو تلحظ مشهداً طبيعياً لا تفصل بين مادة الحروف وهيأتها ولا بين السطور وكلماتها، بل تقرؤها من خلال (الكل) الذي يضمّ الحروف والكلمات والسطور... إلخ، وإذا قدّر لك أن تلحظ كلمة محذوفة أو سطراً مشوّهاً أو خطأ مطبعيّاً، فإنّ ذلك يترك تأثيره السلبي فيك بحيث و(ال ذوقك دون أدنى شك. والسر في ذلك أن إدراكك لصفحة الكتاب تم من خلال نظرتك (الكليّة) لها، لذلك صدم ذوقك وجود (تشويه) فيه: حذف كلمة أو تلطيخها بحبر زائد... إلخ. والأمر نفسه بالنسبة إلى إدراكنا موضوعات الكتاب أو أفكاره، فنحن نقرأ الموضوعات من خلال (تأثيرها الكلي) فينا، بحيث إذا كان الموضوع موسوماً بشيء من خلل في الفكرة؛ أثّر ذلك الخلل في طبيعة تلقّينا للفكرة، وما ذاك إلاّ بسبب تركيبتنا الإدراكية القائمة على أن نتلقّى الأشياء من خلال (الكل) وليس من خلال (الجزء) المنفصل عن ذلك (الكل)...
طبيعيّاً، لا يعني هذا أن إدراك (الجزء) أمر لا يمكن تحقيقه أو أنّه عديم الفائدة مثلاً بل يتمّ ذلك من خلال (الكل) أيضاً، فنحن لم نتحسّس قبح الكلمة المحذوفة أو الملطّخة بالحبر إلاّ لأنها موضوعه ضمن (كل) هو: (وجود كلمات غير محذوفة وغير ملطّخة في صفحة الكتاب، وما عدا ذلك، فإنّ إدراكنا (للجزء) قد يتم من خلال نشاط ذهني (عامد) أو من خلال نشاط ذهني (تلقائي). فنحن قد نبدأ عامدين بملاحظة حروف لكلمة، ثمّ هيئتها، ثمّ السطور، أو نبدأ بتفكيك الأفكار الموجودة فيها فنلاحظها كلاًّ على حدة (لأغراض دراسية ـ كما أشرنا ـ كما لو قام الطبيب بعمليّة تشريح لأجزاء الجسم)، كما أن نشاطنا الذهني القائم على عمليتي (التحليل والتركيب) للظواهر إنّما يرتكن إلى الإدراك من خلال (الجزء) دون أدنى شك: بنمطيه العمدي والتلقائي، إلاّ أن ذلك لا يتم إلاّ من خلال وجود (وحدة) إدراكية تستند إليها عمليتا (التركيب والتحليل)، وإلاّ كيف يمكننا أن (نحلل) شيئاً إذا لم يستند إلى (وحدة) أجزائه، أو كيف يمكننا أن نجمع الأجزاء ونؤلّفها في (مركّب) إذا لم تستند الأجزاء إلى (الوحدة) التي تنتظم المركب المشار إليه.
الأشكال البنائية:
إن هذه الحقائق التي ألممنا بها، تشكّل قواعد بلاغية متصلة بـ(العنصر البنائي) للنص، لذلك أدرجناها ضمن هذا العنوان، بصفة أن النص الأدبي لا يختلف في تخطيط موضوعاته وأهدافه عن التخطيط الذي يمارسه المهندس بالنسبة إلى بناء العمارة، لذلك أطلقنا عنصر (البناء) على القواعد البلاغيّة التي تتناول هذا الجانب من النص الأدبي. ونبدأ الآن بتفصيل ما أجملناه في المقدمة:
إنّ (بناء) النّص الأدبي يتّخذ أشكالاً ومستويات متنوعة من الصياغة الفنيّة، بعضها يتّّصل بالموضوعات، وبعضها يتّصل بالعرض، وبعضها يتّصل بالهيكل الخارجي لها، وبعضها يتّصل بالأدوات الفنية... إلخ.
1- الموضوعات وبناؤها:
أما ما يتصل بالموضوعات، فيمكن القول بأن النص الأدبي من حيث (موضوعه) وصلة ذلك بفكر(1) النص أو الهدف، يتخذ الأبنية التالية:
1- وحدة الموضوع ووحدة الهدف.
2- وحدة الموضوع وتعدّد الأهداف.
3- تعدّد الموضوعات ووحدة الهدف.
4- تعدّد الموضوعات وتعدّد الأهداف المستقلة.
5- تعدّد الموضوعات وتعدّد الأهداف المشتركة.
فمن النموذج الأول (أي: وحدة الموضوع ووحدة الهدف) سورة (الكافرين) حيث إن موضوعها واحد هو (علاقة المؤمن بالكافرين) وهدفها واحد هو (لكلّ عبادته: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ).
ومن النموذج الثاني: (وحدة الموضوع وتعدّد الهدف) (سورة يوسف) حيث إن موضوعها واحد هو: حياة يوسف، إلاّ أن أهدافها متعدّدة مثل مفهوم الصبر، والحسد، والغيرة، و...
ومن النموذج الثالث (تعدّد الموضوعات ووحدة الهدف) سورة الكهف التي أشرنا إليها في مقدمة الكتاب حيث كان مفهوم (زينة الحياة الدنيا) من حيث نبذها أو التشبث بها هو الفكرة أو الهدف الذي حامت عليه موضوعات السورة المتعددة، ومثلها (من السور القصار) سورة (أرأيت) التي كان مفهوم (عدم الإنفاق) هو الطابع المشترك لموضوعاتها المتعددة؛ كما لحظنا.
ومن النموذج الرابع: (تنوّع الموضوعات وتنوّع الأهداف المستقلّة) سورة الصافات (في قسمها الأول) حيث تضمّنت موضوعات مختلفة وأهداف مختلفة، إلاّ أنها مستقلّة، يتم الانتقال من كل موضوع إلى الآخر بواسطة التمهيد له في الموضوع السابق، ففي السورة الكريمة، كان الموضوع الأوّل خاصّاً بالملائكة، وكان الموضوع الآخر هو توحيد الله... وكان الموضوع الثالث هو تزيين السماء الدنيا بالكواكب (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ).
وكان الموضوع الرابع هو: منع الشياطين من الصعود إلى الملأ الأعلى (وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ * لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلأ الأَعْلى... إلخ). وكان الموضوع الخامس هو: سلوك الكافرين (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا... إلخ) وهكذا تتوالى الموضوعات واحداً بعد الآخر إلى نهاية السورة الكريمة... فالملاحظ أن هذه الموضوعات متنوّعة لا علاقة لبعضها مع الآخر فهي تتحدّث عن الله تعالى والملائكة والبشر والشياطين والكواكب... إلخ، لكنها عندما تنتقل من موضوع إلى آخر تمهّد له بما هو مشترك بينهما. فالموضوع الأوّل خُتم بآية (فَالتَّالِياتِ ذِكْراً) والموضوع الثاني بُدئ بآية (إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ) والعلاقة بين الذكر والتوحيد واضحة... والموضوع الثاني ختم بآية (رَبُّ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشارِقِ) بينا بدئ الموضوع الثالث بآية (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ)، والعلاقة بين السماوات والمشارق وبين السماء والكواكب واضحة أيضاً... والموضوع الثالث ختم بقوله (.. الكواكب) والموضوع الرابع بدئ بقوله (وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ) والعلاقة بين الكواكب وحفظه السماء من صعود الشياطين واضحة أيضاً... والموضوع الرابع ختم بقوله تعالى: (... فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ)، والموضوع الخامس بدئ بقوله تعالى: (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا...) والعلاقة بين الشهاب الذي يحجز الشياطين من تحقيق أهدافهم (وهم مخلوقون من نار ومتمكّنون من التحرك في الجور) وبين البشر المخلوق من تراب ولا يملك إمكانيّة الشياطين في التحرك، واضحة أيضاً... وهكذا سائر الموضوعات.
ومن النوع الخامس (أي: البناء القائم على تعدّد الموضوعات وخضوع لمجموعة من الفكر أو الأهداف المشتركة) سورة (مريم) فقد استهلّت السورة حديثها عن زكريا (عليه السلام) (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا * قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً * يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً * قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً * قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً * قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً) هذا الحديث عن زكريّا يتضمّن مجموعة من الفكر والأهداف مثل: (رحمة الله، الإنجاب المعجز، استجابة الدعاء، يسر وسهولة المعجز، العزلة وعدم التكلّم... إلخ. ولو تابعنا موضوعات السورة للحظناها تتحدث عن يحيى، مريم، عيسى، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، موسى، هارون، إسماعيل، إدريس، كما تتحدث عن سلوك المنحرفين والمؤمنين ومصائرهما الأخروية. هذه الموضوعات المختلفة خضعت لفِكَر وأهداف مختلفة هي ذات الفكر والأهداف التي لحظناها في قضيّة زكريا التي استهلّت بها السورة مع تفاوت نشير إلى دلالاته الفنيّة فيما بعد، بيد أن المهم هو أن نشير إلى أن هذا النص يمثّل النوع الآخر من البناء الفنّي القائم على خضوعه لأهداف وفكر متعددة... فمفهوم (الرحمة) مثلاً (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا) قد تردد في موضوعات مريم (وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا) وإبراهيم وإسحاق ويعقوب (وَوَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا) وموسى (وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ...) ومفهوم استجابة الدعاء (وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيّاً) وقد تردّد في كلام إبراهيم (أَلاَّ أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيّاً) ومفهوم الخلق (من قبل) (وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً) قد تردد في موضوع الإنسان المنحرف (أَوَ لا يَذْكُرُ الإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً) ومفهوم العزلة (أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيّاً) تردد في قصة مريم (فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً) وقصة إبراهيم (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ..) ومفهوم الإنجاب المعجز وما واكبه يتردد في قصة مريم، فقد قال زكريا: (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ) وقالت مريم: (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ) وأجيب زكريا: (قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ) وأجيبت مريم: (قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ)... ومفهوم (الرضى) (وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً) تردد في قصة إسماعيل (وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً)... فهذه المحاور وغيرها من المفهومات تظلّ أهدافاً أو أفكاراً (منتثرة) تحوم عليها موضوعات السورة الكريمة.
ـــــــــــــ
الهامش
(1)ـ انظر الفصل الأول (العنصر الفكري).