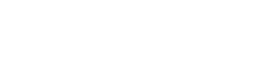محاضرات أصول فقه2 - المحاضرة 8 - القرائن
القرائن:
ويعتمد إفهام معاني الكلام من قبل الملقي وفهمها من قبل المتلّقي على القرائن.
والقرائن - كما سيأتي - هي الدلائل التي تقترن بالكلام أي تصاحبه وتنقسم القرائن إلى:
1- قرائن مقاليّة:
وهي التي يتضمنّها الكلام كقرينة السياق وقرينة الاُسلوب وقرينة الاعراب ونحوها.
2- قرائن مقاميّة:
وهي تلك الدلائل التي تكون خارج إطار الكلام، وتصحبه في بيئته أو أثناء إلقائه.
وسيأتي لها مزيد توضيح وشرح عند حديثنا التالي عن الإعراب.
ومن هنا لابدّ للفقيه من التدقيق في معرفة القرائن لما تلقيه من أضواء كاشفة على النصّ تساعد في فهمه.
والحديث الآتي عن الإعراب سوف يعرب عن هذا.
الإعراب
يعتدّ الإعراب - وبخاصة بنوعه الشكلي - من أهمّ سمات ومميزات الكلام العربي، لأنّه قوام الفصاحة في النطق التي عرف بها العرب.
ومن هنا كان موضع العناية العلميّة الفائقة من قبل علماء اللغة العربية عربا وغيرهم.
ولأنّ النوع الوظيفي منه يتدخّل تدخّلا مباشرا في فهم النصّ رأيت من اللازم منهجيّا التعرّض له، وبخاصة بعد التمهيد له ببيان ما يرتبط بالجملة والكلام اللذين هما محور دورانه ومجال تحرّكه.
حقيقة الإعراب:
اختلف النحّاة العرب - قدامى ومحدثين - في حدّ الإعراب المعرب عن حقيقته.
وخلاصة ما انتهوا إليه هو:
1- أنّ الإعراب هو: الرفع والنصب والجرّ والجزم.
وهذا يعني أن توضع الكلمة المعَربة داخل إطار الجملة في موقع الرفع أو النصب أو الجزم من حقول ترتيب الكلم في الجملة.
2- إنّ الإعراب هو الأثر الذي يجلبه العامل في آخر الكلمة المعربة ويراد بالأثر: العلامة الاعرابية (الضمّة. الفتحة. الكسرة. السكون) وما يقوم مقامها من حركة أو حرف أو حذف أو تقدير.
3- أنّ الإعراب هو تغيّر الأثر الإعرابي الذي يحدث بسبب اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة المعَربة.
فهو ليس الأثر نفسه وإنّما هو تغيّر الأثر.
والذي يلاحظ على هذه التحديدات للإعراب:
أنّ التعريف الأوّل غير جامع، وذلك لأنّ موقع الرفع من غير تحديد لنوعيّة المرفوع ببيان وظيفته النحوية من كونه مبتدأ أو خبرا أو فاعلا - مثلا - يتسع لجميع المرفوعات.
ويلزم عن هذا أنّنا لا نستطيع معه معرفة نوعية الكلمة المرفوعة ومن ثمّ وظيفتها في الجملة، والمقصود من الاعراب الإبانة عن وظيفة الكلمة في منظومة الجملة.
وبتوضيح أكثر:
إنّنا إذا أخذنا مثالا لذلك جملة المبتدأ والخبر فانّها تجدول إلى حقلين، كلّ حقل من الحقلين هو موقع رفع من غير تبيين وتحديد لنوعية المرفوع هل هو مبتدأ أو هو خبر؟
اُنظر الجدول التالي:
|
رفع |
رفع |
|
زيد |
عالم |
|
عالم |
زيد |
فكلمة (زيد) وقعت في الحقل الأوّل وفي الحقل الثاني، وكذلك كلمة (عالم) وقعت في الحقل الأوّل وفي الحقل الثاني، ولم يميّز الرفع بينهما، فيعرب عن أنّ هذه مبتدأ وتلك خبر.
وكذلك إذا قلت:
أعالِم زيد.
فالحقل لكلمة (زيد) حقل رفع لكنّه لا يقوى على بيان انّها فاعل.
فالتعريف - على هذا - قاصر عن بيان وظيفة الكلمة في الجملة، الأمر المطلوب من الاعراب أن يعرب عنه.
وكذلك التعريفان الآخران لأنّهما يدوران حول دليلة من دلائل الإعراب، وهي الحركة وما يقوم مقامها.
والحركة وحدها لا تفصح عن وظيفة الكلمة في الجملة، وإنّما تبيّن أنّ هذه الكلمة معربة، وعلامة إعرابها الضمّة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون.
يعني أنّنا علينا أن ننطق بها مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة أو ساكنة.
والتغيّر لا يدلّ على أكثر ممّا تدلّ عليه الحركة فهو لا يعرب عن وظيفة الكلمة في الجملة، ولا حتّى عن نوعية الحقل الاعرابي لها.
والحقّ:
إنّ الإعراب: هو الإبانة عن الوظيفة النحوية للكلمة في منظومة الجملة.
ولتوضيح هذا لابدّ من الدخول إليه عن طريق بيان أقسام وقرائن الإعراب.
أقسام الإعراب:
1- الإعراب الشكلي:
وهو النطق بالكلمة في سياق الكلام كما نطق بها العرب الفصحاء من حيث إخراج الحروف من مخارجها وتشكيل كلّ حرف من حروف الكلمة من أوّل حرف إلى آخر حرف من حروفها بشكلته ضمّة كانت أو فتحة أو كسرة أو سكونا أو شدّة أو مدّة، وكما كان يشكلها العرب الفصحاء.
وهو المقصود في الأحاديث الشريفة الآمرة باعراب القرآن، وكذلك الفتاوى الملزمة بالإعراب في القراءة الواجبة في الصلاة.
2- الإعراب الوظيفي:
وهو الإعراب الذي يبيّن وظيفة الكلمة في الجملة فيتدخّل تدخّلا مباشرا وأساسيّا في فهم النصّ.
ومن هنا اعتبر تعلّم الصرف والنحو والبلاغة مقدّمة ضرورية لتعلم الفقه والإجتهاد فيه.
3- الإعراب التطبيقي:
وهو الإعراب المعروف الذي يستخدم في تدريب الطلاب على فهم قواعد اللغة وحفظها.
ومنه ما في الكتب المؤلّفة في إعراب القرآن وإعراب الحديث وإعراب ألفية ابن مالك ونحوها.
والمقصود دراسته هنا هو الإعراب الوظيفي لأنّنا في علم اُصول الفقه ندرس في مباحث الألفاظ ظهورات الألفاظ، والإعراب الوظيفي له تدخل مباشر وأساسي في فهم مدلول النصّ.
أمّا القرائن اللفظيّة فهي كالتالي:
1- العلامة: وقد حصرتها بالحركات الثلاث، وهي تنقسم إلى:
أ- الحركات القصيرة وهي: الضمّة والفتحة والكسرة.
ب- الحركات الطويلة وهي: الواو والألف والياء.
ومواضعها: الأسماء المتغيّرة، وهي التي تعرف في رأي النحّاة بما يعرب بالحركات الظاهرة أو بالحروف.
وذلك لأنّ جميع الأفعال - فيما أرى - مبنيّة، وكما أوضحت هذا في كتابي (دراسات في الفعل)(1)، والحروف جميعها مبنيّة بالإتفاق، ولأنّ جميع الأسماء فيما أرى - معربة، ومنقسمة - باعتبار وجود الحركة على آخرها ولا وجودها وتغيّر الحركة ولا تغيّرها - إلى:
أ- اسم متغيّر: وهو ما اختلفت عليه الحركات الإعرابية.
ب- اسم ثابت: وهو ما لازم آخره علامة واحدة سكونا كانت كالأسماء المقصورة والمنقوصة في حالتي الرفع والجرّ، أو حركة كالإسم المضاف لياء المتكلّم وأمثاله من المفردات.. وهي جميع الأسماء التي تعرب في رأي النحّاة بالإعراب التقديري أو الإعراب المحلّي..(2).
الصيغة:
ويراد بها مجيء الكلمة على هيئة خاصّة للدلالة على معنى معيّن، كما في الظواهر التالية:
أ- صيغة الفعل المبني للمعلوم، التي تدلّ على أنّ مرفوعها فاعل.
ب- صيغة الفعل المبني للمجهول، التي تدلّ على أنّ مرفوعها نائب فاعل.
ج- صيغة المفعول المطلق - إذا كان مصدرا - التي تدلّ عليه بمعونة قرينتي العلامة (الفتحة) والدلالة.
د- صيغة المفعول له التي لا تأتي إلا مصدرا فتدلّ عليه بمساعدة قرينتي العلامة (الفتحة) والدلالة إذا كان منصوبا، أو قرينتي العلامة (الكسرة) والدلالة والأداة (لام التعليل) إذا كان مجرورا.
هـ- صيغ الضمائر لأنّها تدلّ على الحالة الإعرابية للضمير رفعا أو نصبا في الضمائر المنفصلة، ورفعا أو نصبا وجرّا في الضمائر المتصلة.
3- الرتبة:
وتأتي في تعيين المبتدأ والخبر، والفاعل والمفعول به.
وتقوم قرينيتها أو دلالتها في حالة فقدان القرائن الاُخرى المعيّنة والمميزة لكلّ من المبتدأ والخبر أو الفاعل والمفعول حيث تخضع الجملة للترتيب الأوّلي لها فيعرب الإسم الأوّل مبتدأ والثاني خبرا في جملة المبتدأ والخبر، وهو ما أشار إليه ابن مالك في قوله:
وامنعه حين يستوي الجزآن***** عرفا ونكرا عادمي بيان
ويعرب الإسم الأوّل فاعلا والثاني مفعولا في جملة الفاعل، وهو ما أشار إليه ابن مالك بقوله:
وأخّر المفعول إن لبس حذر.
4- الأداة:
ويراد بها ما يعرف بالأدوات العاملة في الأسماء عند النحّاة أمثال:
أ- كان وأخواتها.
ب- ليس وأخواتها (ما. لا. لات).
ج- إنّ وأخواتها.
د- لا النافية للجنس.
هـ’- ظنّ وأخواتها.
و- واو المعيّة مع المفعول معه.
ز- لام التعليل مع المفعول له.
ح- إلا الاستثنائية وأخواتها.
ط- حروف الجرّ.
5- الاُسلوب:
وأعني به اختلاف الحركة الإعرابية المقترن باختلاف التركيب أو الصورة اللفظيّة كما في أمثال:
أ- اسم الفاعل المستعمل بأسلوبين هما:
-1أن يكون منونا فيقتضي الاُسلوب مجيء مفعوله منصوبا.
-2أن يكون غير منوّن فيقتضي الاُسلوب مجيء مفعوله مجرورا بإضافته إليه.
فمن تنوينه يستدلّ على نصب مفعوله، وبعدم تنوينه يستدلّ على جرّ مفعوله بإضافته إليه.
ومن شواهده جاء في (معاني القرآن) للفراء(3): وقوله: (ذلكم وأنّ اللَّه موهن كيد الكافرين) و (موهن) فإن شئت أضفت، وإن شئت نوّنت ونصبت، ومثله (إنّ اللَّه بالغُ امرهِ) و (بالغٌ أمرَه) و (كاشفاتُ ضرهِ) و (كاشفاتٌ ضرَه...(
ب- الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بمفعوله، وعدم الفصل، كما في الآية الكريمة: (وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتلُ أولادِهم شركائُهم) وهي في قراءة السبعة غير ابن عامر، و (وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائِهم) وهي قراءة ابن عامر، فكلّ منهما اُسلوب.
ج- المصدر مع فاعله ومفعوله فله اُسلوبان، كلّ منهما قرينة على تحديد إعراب الفاعل والمفعول، ففي الآية القرآنية السابقة لو أخذت شاهدا هنا لجاز أن يقال: (زيّن لكثير من المشركين قتلُ أولادِهم شركاؤهم) بإضافة المصدر إلى مفعوله ورفع فاعله.
وجاز أن يقال: زيّن لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائهم بإضافة المصدر إلى فاعله ونصب مفعوله.
6- السياق:
ويراد به نظم الكلام وما يشتمل عليه من دلائل تحدّد وتعيّن إعراب الكلمة التي اقترنت بها، كما في الأمثلة التالية:
أ- قوله تعالى: (وكفلها زكريا) فقد قرئ الفعل بالتخفيف وهو قرينة على أنّ (زكريا) فاعل، وقرئ بالتشديد وهو قرينة على أنّ (زكريا) مفعول به.
ب- قوله تعالى: (وقالت اليهود: عزير ابن اللَّه)، فإنّ سياق هذه الفقرة من الآية الكريمة والذي تتمّ به وهو (وقالت النصارى: المسيح ابن اللَّه، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم اللَّه أنّى يؤفكون)، هذا السياق يقتضي تنوين كلمة (عزير) وإعراب كلمة (ابن) خبرا لكلمة (عزير)، كما يقتضي كتابة كلمة (ابن) بالهمزة لأنّها لم تقع وصفا.
وبهذا جاءت قراءة عاصم والكسائي ويعقوب.
وظيفة الإعراب:
وقد تطرّق لتعريف وبيان هذا الدور الوظيفي للإعراب غير واحد من النحّاة، منهم:
- الزجّاجي: قال تحت عنوان (باب القول في الإعراب لِمَ دخل في الكلام): فإن قال: فقد ذكرت أنّ الإعراب داخل في الكلام، فما الذي دعا إليه، واحتيج إليه من أجله؟
الجواب: أن يقال: إنّ الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة، ومضافا إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلّة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني، فقالوا: (ضرب زيد عمرا) فدلّوا برفع (زيد) على أنّ الفعل له، وبنصب(عمرو) على أنّ الفعل واقع به.
وقالوا: (ضرب زيد) فدلّوا بتغيير أوّل الفعل ورفع (زيد) على انّ الفعل ما لم يسمّ فاعله، وأنّ المفعول قد ناب منابه.
وقالوا: (هذا غلام زيد) فدلّوا بخفض (زيد) على إضافة (الغلام) إليه.
وكذلك سائر المعاني، جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتّسعوا في كلامهم، ويقدّموا الفاعل إن أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالّة على المعاني.
- ابن الخشّاب، قال: وفائدته (يعني الإعراب) أنّه يفرّق بين المعاني المختلفة التي لو لم يدخل الإعراب الكلمة التي تتعاقب عليها تلك المعاني التبست.
والمثال في ذلك: المسألة المذكورة، وهي قولهم (ما أحسنَ زيدا) و (ما أحسنُ زيدٍ) و (ما أحسنُ زيدٌ).
صيغة الكلام واحدة، ومعانيه مختلفة، فإذا نصبت (زيدا) وفتحت النون من (أحسن) كان الكلام تعجبا، وإذا رفعت (زيدا) مع فتح النون (من أحسن) كان الكلام نفيا للإحسان عنه، وإذا رفعت النون من (أحسن) وجررت (زيدا) كان الكلام استفهاما عن الشيء الذي هو أحسن ما في زيد، كأنّك سألت: أعين زيد أحسن ما فيه أم أنفه أم فمه، إلى غير ذلك ممّا يصحّ الاستفهام عنه منه، فلولا اختلاف الحركات التي هي الرفع والنصب والجرّ المتعاقبة على دالّ زيد، التبست هذه المعاني، فلم يكن بين بعضها وبعض فرق في اللفظ.
إلى غير ذلك من المسائل التي نتبيّن فيها فائدة الإعراب(4).
- الدكتور وافي، قال: تمتاز اللغة العربية في شؤون التنظيم syntaxeبتلك القواعد الدقيقة التي اشتهرت باسم قواعد الإعراب، والتي يتمثّل معظمها في أصوات مدّ قصيرة تلحق أواخر الكلمات لتدلّ على وظيفة الكلمة في العبارة وعلاقتها بما عداها من عناصر الجملة.
وهذا النظام لا يوجد له نظير في أيّة اُخت من أخواتها السامية، اللهمّ إلّا بعض آثار ضئيلة بدائية في العبرية والآرامية والحبشية(5).
ونخلص من كلّ ما تقدّم إلى أنّ الإعراب المدلول عليه بالقرائن هو الذي يقوم بوظيفة تحديد الموقع الإعرابي للكلمة المعربة (الاسم) في الجملة، ويبيّن لنا وظيفتها النحوية من فاعلية ومفعولية وإضافة وما إليها.
الهوامش:
(1)-اُنظر: موضوع(بناء الفعل) ص 61.
(2)- راجع(دراسات في الإعراب): موضوع (مادّة الإعراب).
(3)- 1/406.
(4)- المرتجل 34.
(5)- فقه اللغة 21.