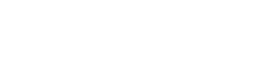محاضرات أصول فقه2 - المحاضرة 45 - الروايات
- الروايات:
وهي كثيرة، ولكن أهمّها، وعليها الإعتماد في الإستدلال بها على حجيّة الإستصحاب الصحاح الثلاث لزرارة بن أعين، وتليها موثّقة عمّار وروايتا محمّد بن مسلم وعبداللَّه بن سنان ثمّ مكاتبة القاساني.
وتتنوّع هذه الروايات نوعين:
- مقنّنة للقاعدة كرواية محمّد بن مسلم وموثّقة عمّار.
- ومطبقة للقاعدة على مواردها كصحاح زرارة.
وقد أطال القوم البحث فيها قبولا ورفضا وإحكاما ونقضا، بما حمّل النصّ بأكثر ممّا يتحمّل، ونأى به عن طبيعة الأساليب العربية في الدلالة وأداء المعنى.
ويرجع هذا إلى عدم التعامل معها وفق الاُصول اللغوية الإجتماعيّة، والروايات لأنّها نصوص لغوية إجتماعيّة تلزمنا أن نتعامل معها وفق متطلّبات البحث اللغوي الإجتماعي، وبخاصة إنّها انطلقت في بيان الحكم على أساس من تقنين القاعدة وتطبيقها باعتبارها من المرتكزات العرفيّة المسلمة.
وهي - أعني الروايات - بهذا التقنين والتطبيق لقاعدة الإستصحاب على مواردها تكون قد أمضت وأقرّت بناء العقلاء في اعتماد هذه الظاهرة شرعا.
فهي - أي الروايات - تعضد السيرة العقلائيّة فتتكاملان في إفادة هذه القاعدة وصحّة الإستناد إليها والعمل بها.
وإليك نصوص الروايات مع بعض التعليقات:
1- الصحيحة الاُولى لزرارة:
قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟
قال: يازرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاُذن، فإذا نامت العين والاُذن فقد وجب الوضوء.
قلت فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟
قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيئ من ذلك أمر بيّن، وإلا فانّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ، ولكن ينقضه بيقين آخر.
وأشكل بعضهم بأن (أل) في كلمة (اليقين) وكلمة (الشكّ) ربّما كانت للعهد لا للجنس، فتختص القاعدة بباب الوضوء ولا مجال إلى تعميمها إلى غيره.
وأجاب عنه اُستاذنا الشهيد الصدر في (الحلقة الثالثة)(1) بقوله: وتقريب الإستدلال: أنّه حكم ببقاء الوضوء مع الشكّ في انتقاضه تمسكا بالإستصحاب.
وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الإستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، فيتعيّن حمل اللام في اليقين والشكّ على الجنس لا العهد إلى اليقين والشكّ في باب الوضوء خاصة.
2- الصحيحة الثانية لزرارة:
قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني، فعلّمت أثره إلى ان اُصيب له الماء، فحضرت الصلاة، ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟
قال(عليه السلام) تعيد الصلاة وتغلسه.
قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وعلمتُ انَّه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته؟
قال(عليه السلام): تغسله وتعيد.
قلت: فإن ظننت انّه أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت ما فيه؟
قال: تغسله وتعيد.
قلت: لِمَ ذلك؟
قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا.
قلت: فإنّي قد علمت انّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟
قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك.
قلت: فهل عليّ إن شككت انّه أصابه شيء أن أنظر إليه؟
قال: لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشكّ الذي وقع في نفسك.
قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه، ثمّ رأيته، وان لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أُوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ.
قال اُستاذنا التقي الحكيم في (الاُصول العامّة)(2): وهذه الرواية من أهمّ الروايات وأصحّها، وقد اشتملت على عدّة مسائل فقهيّة أثارها عمق الراوي ودقّة نظرته، وقد تحدّث عنها الأعلام أحاديث مفصّلة، ولكنّها لا تتصل بطبيعة بحثنا هذا، وما يتّصل منها بموضع الحاجة قوله(عليه السلام) في مقامين منها: (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ)، وهي كبرى كليّة طبّقها (عليه السلام) على بعض مصاديقها في المقامين.
والذي يبدو من التعبير (فليس ينبغي) وهي كلمة لا تقال عادةً في غير مواقع التأنيب أو العتب، ولا موضع لهما هنا لو لم تكن هذه الكبرى مفروغا عنها عند الطرفين، وهي من المسلّمات لديهما.
كما أنّ التعليل فيها (لأنّك كنت على يقين)، وإرساله على هذا النحو من الإرسال يوحي أنّه تعليل بأمر مرتكز معروف، وهو ما سبق ان استقربناه عند الإستدلال ببناء العقلاء من انّه من الاُمور التي يصدر عنها الناس في واقعهم صدورا تلقائيا، لعلّ مصدره ما ذكره شيخنا النائيني من الهام اللَّه لهم ذلك، أو ما عبّر عنه الاُستاذ خلاّف بفطرة اللَّه الناس عليها، فهي - في الحقيقة - من أدلّة الإمضاء لما عليه بناء العقلاء.
3- الصحيحة الثالثة لزرارة:
قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز ثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات، وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهّد، ولا شيء عليه.
وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها اُخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشكّ، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات.
قال الشيخ الأنصاري في (الرسائل)(3): وقد تمسّك بها في (الوافية)، وقرّره الشارح، وتبعه جماعة ممّن تأخّرعنه.
4- موثّقة عمّار عن أبي الحسن(عليه السلام).
قال: إذا شككت فابْن على اليقين.
قلت: هذا أصل؟
قال(عليه السلام): نعم.
يقول اُستاذنا الحكيم في (الاُصول العامّة)(4): ودلالتها على الحجيّة واضحة، وبخاصة إذا تصوّرنا انّه لا معنى للبناء على اليقين إلا البناء على المتيقّن.
والتعبير بـ(هذا أصل) يدلّ على سعة القاعدة، وعدم تقييدها في الموارد التي بعثت بالسائل على الإستفسار والسؤال.
5- رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه(عليه السلام):
قال: قال أمير المؤمنين - صلوات اللَّه وسلامه عليه -: مَن كان على يقين فشكّ، فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين.
وفي رواية اُخرى عنه: مَن كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ.
قال الشيخ الأنصاري في (الرسائل)(5): وعدّها المجلسي في (البحار) في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكليّة، فقد أدرجها في (باب) 32ضمن قائمة (ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار من متفرّقات مسائل اُصول الفقه).
6- رواية عبداللَّه بن سنان:
قال: سأل أبي أبا عبداللَّه(عليه السلام) وأنا حاضر - أنّي اُعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن اُصلّي فيه؟
فقال أبو عبداللَّه(عليه السلام): صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر، ولم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه.
علّق عليها الشيخ الأنصاري في (الرسائل)(6) بقوله: وفيها دلالة واضحة على انّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها.
ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.
نعم، الرواية مختصة باستصحاب الطهارة دون غيرها، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ممّا يشكّ في إرتفاعها بالرافع.
7- مكاتبة علي بن محمّد القاساني:
قال: كتبت إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان: هل يصام أم لا؟
فكتب(عليه السلام): اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية.
علّق عليها الشيخ الأنصاري في (الرسائل)(7) بقوله: والإنصاف انّ هذه الرواية أظهر ما في الباب من أخبار الإستصحاب إلا انّ سندها غير سليم.
وبعد، فما مدى سعة مشروعيّة الإستصحاب بين تلك التفصيلات التي مرّت في الأقوال بقضيّة الإستصحاب؟
انّ رواية محمّد بن مسلم: مَن كان على يقين فشكّ، فليمض على يقينه فإنّ الشكّ لا ينقض باليقين أو مَن كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ - وهي أقدم الروايات المرويّة كلّها حيث رويت عن أمير المؤمنين(عليه السلام) - بما فيها من تقنين للقاعدة، وبما تحمل من إطلاق، مضافا إلى انّها ليست تطبيقا على واقعة جزئيّة كما في الروايات الاُخر.
كلّ هذا يفيدنا مشروعيّة الإستصحاب وحجيّته على نحو الإطلاق.
ومثل رواية محمّد بن مسلم موثّقة عمّار: إذا شككت فابْن على اليقين.. قلت: هذا أصل؟.. قال: نعم.
فما فيها من إطلاق، والتعبير عنها بأنّها (أصل) المراد به معنى القاعدة، يفيد أيضا انّ الإستصحاب حجّة مطلقا.
بين الأمارة والأصل:
من مسائل الإستصحاب التي أثارها متأخّروا المتأخّرين تصنيفه بتعيين موقعه في قائمة الأدلّة:
- فهل هو من الأمارات؟
- أو هو من الاُصول العمليّة؟
وإذا كان أصلا:
- فهل هو أصل إحرازي؟
- أو هو أصل غير إحرازي؟
يقول الشيخ الأنصاري: إنّ عدّ الإستصحاب من الأحكام الظاهريّة الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم، نظير أصل البراءة وقاعدة الإشتغال، مبني على إستفادته من الأخبار.
وأمّا بناءً على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظنّي اجتهادي، نظير القياس والإستقراء على القول بهما.
وحيث انّ المختار عندنا هو الأوّل، ذكرناه في الأُصول العمليّة المقرّرة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم.
لكنّ ظاهر كلمات الأكثر، كالشيخ والسيّدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم، كونه حكما عقليّا، ولذا لم يتمسّك أحد هؤلاء فيه بخبر من الأخبار.
نعم، ذكر في (العدّة) انتصارا للقائل بحجيّته ما روي عن النبي(صلى الله عليه وآله) من (أنّ الشيطان ينفخ بين إليتي المصلّي، فلا ينصرفن أحدكم إلا بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا).
الهوامش:
(1)- 2/ 210.
(2)- ص 463- 464.
(3)- 2/ 567.
(4)- ص 464.
(5)- 2/ 569.
(6)- 2/ 571.
(7)- 2/ 570.