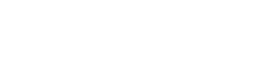محاضرات أصول فقه2 - المحاضرة 29 - تخصيص العامّ بالمفهوم
تخصيص العامّ بالمفهوم:
تقدّم أنّ المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وعلى أساس من هذا التقسيم ينشعب البحث إلى شعبتين، هما:
أ- التخصيص بمفهوم الموافقة:
وهذا لا خلاف فيه بين القوم.
ومثّل له الآمدي في (الأحكام)(1) بما لو قال السيّد لعبده: (كلّ من دخل داري فاضربه)، ثمّ قال: إن دخل زيد داري فلا تقل له: اُف)، فإنّ ذلك يدلّ على تحريم ضرب زيد وإخراجه عن العموم، نظرا إلى مفهوم الموافقة.
ومثّل له اُستاذنا الشيخ المظفّر في (الاُصول)(2) بـ(قوله تعالى: (اُوفوا بالعقود) فإنّه عام يشمل كلّ عقد يقع باللغة العربية وغيرها، فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي فقد قيل: إنّه يدلّ بالأولوية على اعتبار العربية في العقد، لأنّه لما دلّ على عدم صحّة العقد بالمضارع من العربية فلئن لم يصحّ من لغة اُخرى فمن طريق أولى.
ثمّ قال: ولا شكّ انّ مثل هذا المفهوم إن ثبت فإنّه يخصّص العام المتقدّم، لأنّه كالنصّ أو أظهر من عموم العامّ فيقدّم عليه.
ب- التخصيص بمفهوم المخالفة:
وقد وقع هذا التخصيص موقع الخلاف بينهم، وعلى أربعة أقوال، هي:
1- المنع من التخصيص بالمفهوم مطلقا.
2- جواز التخصيص به مطلقا.
3- التفصيل، فإنّه يفهم من إشارات كلام البعض أنّه لا يخصّص لأنّ العبارة (يعني المنطوق) أقوى، إلا إذا خصّ بعبارة قاطعة أوّلا - كما ذكر هذا في (فواتح الرحموت بهامش المستصفى)(3).
4- التوقّف، وإعتبار الكلام مجملا.
ثمّ علّل هذا الخلاف فقال: والسرّ في هذا الخلاف أنّه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوّة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق، وقع الكلام في:
- أنّه أقوى من ظهور العامّ فيقدّم عليه.
- أو أنّ العامّ أقوى فهو المقدّم.
- أو أنّهما متساويان في درجة الظهور فلا يقدّم أحدهما على الآخر.
- أو أنّ ذلك يختلف باختلاف المقامات.
والحقّ انّ مسألتنا هذه لا تختلف عن مسائل التخصيص الاُخرى التي اعتمد فيها تقديم القرينة الذي هو الخاص على صاحب القرينة الذي هو العامّ.
فتقديم المفهوم - هنا - لأنّه الخاص على المنطوق الذي هو العام بحمل العامّ على الخاص، هو من هذا الباب وتطبيق لهذه القاعدة.
يقول شيخنا المظفّر: والحقّ أنّ المفهوم لما كان أخصّ من العام - حسب الفرض - فهو قرينة عرفا على المراد من العامّ، والقرينة تقدّم على ذي القرينة، وتكون مفسّرة لما يراد من ذي القرينة، ولا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة.
ولعلّه - أعني كون القرينة - هنا - ليست بأقوى من صاحبها، لأنّها مفهوم وصاحبها منطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم - جعل القائلين بالمنع ينكرون التخصيص بالمفهوم.
وقد أثار الآمدي في (أحكامه)(4) هذه الشبهة وردّها، قال: فإن قيل: المفهوم وان كان خاصّا وأقوى في الدلالة من العموم، إلا أنّ العامّ منطوق به، والمنطوق أقوى في دلالته من المفهوم لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق، وعدم افتقار المنطوق في دلالته إلى المفهوم.
قلنا: إلا أنّ العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقا، ولا كذلك بالعكس، ولا يخفى أنّ الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر.
ومثّل له الآمدي بقوله: لو ورد نصّ عامّ يدلّ على وجوب الزكاة في الأنعام كلّها، ثمّ ورد قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): (في الغنم السائمة زكاة) فإنّه يكون مخصّصا للعموم بإخراج معلوفة الغنم من وجوب الزكاة بمفهومه.
تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده:
من الأساليب اللغوية المستعملة إجتماعيا والتي ترتبط بالعامّ، وجاء منها شيء في نصوصنا الشرعيّة هو الاُسلوب المؤلّف من:
عامّ بعده جملة مرتبطة به لاشتمالها على ضمير يعود إلى بعض أفراد ذلك العامّ بدلالة قرينة خاصة أبانت عن عود الضمير على بعض أفراد العامّ، والحكم في الجملة المشتملة على الضمير مخالف لحكم العام.
هذا هو الاُسلوب موضوع البحث.
والنقطة التي يثيرها البحث الاُصولي هي: هل هذه الجملة المشتملة على الضمير والمخالفة في حكمها لحكم العامّ لها القدرة على تخصيص العامّ أو ليس لها ذلك؟
وقد استفيد تحديد الموضوع بما ذكرته من حاق النصوص الشرعيّة التي وقف عليها الاُصوليون، وهي أمثال قوله تعالى: (والمطلّقات يتربصنّ بأنفسهنّ ثلاثة قروء... وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ)، فـ(المطلّقات) هو العامّ لأنّه يشمل الرجعيّات والبائنات، والجملة التي جاءت بعده مرتبطة به هي (وبعولتهنّ أحقّ بردهنّ)، والضمير هو الهاء في (بعولتهنّ) و (ردهنّ) وهو يعود على الرجعيّات للقرينة الدالّة على ذلك، وهي الروايات الواردة في المسألة حيث قصرت حقّ الرجوع للرجل في زوجته المطلّقة طلاقا رجعيّا فقط.
وذكروا أنّ في المسألة ثلاثة أقوال، ولكن اختلفوا في اُسلوب طرحها بما يجعل هذه الأقوال اثنين لا ثلاثة.
- ففي (القوانين): إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله:
فقيل: إنّه يخصّص.
وقيل: لا.
وقيل: بالوقف.
والذي يبدو من الآخرين أنّ المراد بالتخصيص معناه المعروف، وهو رفع اليد عن ظهور العام في العموم الشامل لجميع أفراده والإقتصار به على ما عدا ما أخرجه الخاص.
والمراد بعدم التخصيص إبقاء العامّ على عمومه والتجوّز في عود الضمير بحمله على الاستخدام.
ومن هنا صيغت الأقوال الثلاثة في عبارة بعضهم بالتالي:
1- القول بالتخصيص برفع اليد عن ظهور العامّ في العموم الشامل لجميع أفراده، وقصر على ما عدا ما يخرجه الخاصّ.
2- القول بالتخصيص بإبقاء العامّ على عمومه مع التصرّف في الضمير بحمله على الإستخدام (وذلك بأن يراد باللفظ معناه الحقيقي، وبالضمير معناه المجازي)، أي يراد بلفظ (المطلّقات) - في مثالنا - معناه العامّ الشامل للرجعيّات والبائنات، ويراد بالضمير العائد عليه الرجعيّات فقط فيكون استعماله فيه مجازيا من باب استعمال الكلّ في البعض.
3- التوقّف في المسألة.
ومنشأ الخلاف في المسألة وتعدّد الأقوال فيها، هو انّ التخصيص لا يتحقّق إلا بارتكاب إحدى المخالفتين التاليتين:
1- مخالفة ظهور العامّ في العموم بأن يجعل مخصوصا بالبعض الذي يرجع إليه الضمير.
2- مخالفة ظهور الضمير في رجوعه إلى ما تقدّم عليه من المعنى الذي دلّ عليه اللفظ بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام، فيراد منه البعض، والعامّ يبقى على دلالته على العموم(5).
وعلى أساس من هذا صاغ شيخنا المظفّر الأقوال الثلاثة بعبارة اُخرى حيث قال: فأي المخالفتين (يعني المذكورتين في أعلاه) أولى؟ وقع الخلاف على أقوال ثلاثة:
الأوّل: أنّ أصالة العموم هي المقدّمة فيلتزم بالمخالفة الثانية. وهو القول الثاني في التسلسل المتقدّم.
الثاني: أنّ أصالة عدم الاستخدام هي المقدّمة فيلتزم بالمخالفة الاُولى، وهو القول الأوّل في التسلسل المتقدّم.
الثالث: عدم جريان الأصلين معا والرجوع إلى الاُصول العمليّة، وهو ما عبّر عنه الآخرون بالتوقف، أي القول الثالث في التسلسل المتقدّم.
والذي ينبغي أن ينظم عليه البحث من ناحية منهجيّة، هو أن يقال: إنّ الرأي الاُصولي في هذه المسألة يتمثّل في قولين، هما: التخصيص والتوقّف.
ووقع الخلاف في كيفيّة تصوير أو تحقّق التخصيص:
- هل هو بالتصرّف في ظهور العامّ في العموم؟
- أو بالتصرّف في ظهور عود الضمير؟
والواقع أنّ التصرّف الذي ذكروه لا نحتاج إليه بعد قيام الدليل على تعيين ما يعود عليه الضمير، إلا انّه محذوف وفي نيّة المذكور، فيكون حال التخصيص هنا حاله في سواه.
ففي الآية الكريمة يكون التقدير بهدي القرينة كالتالي: (والمطلّقات يتربصنّ بأنفسهنّ ثلاثة قروء... والرجعيّات بعولتهنّ أحقّ بردهنّ).
هذا ما توحي به دلالة القرينة الخاصّة.
فالراجح هو القول بالتخصيص للقرينة الخارجية الدالة على ذلك، من غير نظر إلى ما ذكر من تعارض الأمرين، وأيّهما يقدم.
الهوامش:
(1)- 2/ 479.
(2)- 1/ 143.
(3)- 1/ 353.
(4)- 2/ 479.
(5)- اُصول المظفر 1/140.