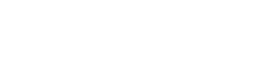محاضرات أصول فقه2 - المحاضرة 24 - أسماء الإستفهام
6- أسماء الإستفهام:
يقال: (استفهمه): سأله أن يفهمه، ويقال: (استفهم من فلان عن الأمر): طلب منه أن يكشف عنه فهو - باختصار - طلب الفهم والعلم بالشيء.
والفهم: هو حسن تصوّر المعنى، وجودة استعداد الذهن للاستنباط.
ويتمثّل عموم هذه الأسماء في أنّها سيتفهّم بها عن شيء غير معيّن يطلب تعيينه من بين أفراد تشاركه في عموم يشملها جميعا.
أي أنّ عمومها من نوع العموم البدلي، ففي قوله تعالى: (إذ قال لبنيه: ماتعبدون من بعدي) المقصود الاستفسار عن أي إله يعبده بنوه من بعده، وفي قوله: (فأين تذهبون) أي إلى أي مكان يذهبون.
وللاستفهام في لغتنا العربية أدوات خاصة يستفهم بها، وتنقسم إلى حروف وأسماء.
والحروف هي: الهمزة وهل.
والأسماء هي: من، ما، متى، أين، أيّان، أنّى، كيف، كم. أي.
والمقصود منها - الأسماء.
والكلام فيها وحولها هو الكلام في أسماء الشرط.
ومن أمثلتها:
(قل لمن ما في السموات والأرض قل للَّه).
(إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي).
(وزلزلوا حتّى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللَّه).
(يسألون أيّان يوم القيامة).
(يقول الإنسان يومئذ أين المفرّ).
(فأين يذهبون).
(ويريكم آياته فأي آيات اللَّه تنكرون).
(أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كلّ زوج كريم).
(قل سيروا في الأرض ثمّ انظروا كيف كان عاقبة المكذّبين).
والضابط - هنا - لمعرفة العموم المدلول عليه بالأداة هو صحّة حلول (أي) محلّ الأداة.
7- الأسماء الموصولة:
عرّف الاسم الموصول بانّه اسم غامض مبهم يحتاج دائما في تعيين مدلوله وإيضاح المراد منه إلى أحد شيئين بعده: إمّا جملة، وإمّا شبهها، وكلاهما يسمّى صلة الموصول(1).
والمقصود - هنا - من هذه الأسماء هو: من، ما (إذا دلّتا على جمع)، الذين، اللائي، اللاتي.
ومن أمثلتها:
(وللَّه يسجد مَن في السموات ومن في الأرض).
(وأحلّ لكم ما وراء ذلكم).
(والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا يتربصنّ بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا).
(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم).
والضابط لمعرفة العموم في هذه الأسماء هو إضافة كلمة (كلّ) أو (جميع) إلى الاسم.
تقول في الآية الاُولى:(للَّه يسجد كلّ من في السموات وجميع من في الأرض).
وفي الآية الأخيرة: (وكل اللائي يئسن...).
أقسامهما:
من المفيد - هنا - أن نبدأ بذكر التقسيمات اللغوية العربية للعام والخاص، لأنّها تنطلق من واقع الاستعمالات الاجتماعية لهما، وبما يلقي الضوء على نشأة الاستعمالات الاجتماعية المشار إليها وتطوراتها من حيث الاُسلوب والدلالة.
- تقسيم ابن فارس:
قسّم ابن فارس في (الصاحبي) العامّ والخاص من واقع الاستعمال الاجتماعي من حيث الاُسلوب والدلالة إلى ثلاثة أقسام، هي:
1- اُسلوب يدلّ على الخاص والعامّ معا:
قال: وقد يكون الكلامان متّصلين، ويكون أحدهما خاصّا والآخر عامّا.
وذلك قولك لمن أعطى زيدا درهما: اعط عمرا فإن لم تفعل فما أعطيت، تريد أن لم تعط عمرا فأنت لم تعط زيدا أيضا، وذلك غير محسوب لك.
ومثله في كتاب اللَّه - جلّ ثناؤه -: (ياأيّها الرسول بلّغ ما اُنزل إليك من ربّك) فهذا خاص يريد هذا الأمر المجدّد بلّغه، فإن لم تفعل ولم تبلّغ (فما بلّغت رسالته) يريد جميع ما أُرسلت به.
2- اُسلوب ظاهر في العام يراد به الخاص:
قال: وأمّا العام الذي يراد به الخاص فكقوله - جلّ ثناؤه - حكايةً عن موسى(عليه السلام): (وأنا أوّل المؤمنين)، ولم يرد كلّ المؤمنين لأنّ الأنبياء قبله قد كانوا مؤمنين.
ومثله كثير، ومنه:
(قالت الأعراب آمنا)، وإنّما قاله فريق منهم.
(والذين قال لهم الناس إنّ الناس)، إنّما قاله نعيم بن مسعود، إنّ الناس: أبو سفيان وعيينة بن حصن.
ومنه قوله - جلّ ثناؤه -: (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذّب بها الأوّلون) أراد الآيات التي إذا كذب بها نزل العذاب على المكذّب.
وكذلك قوله: (ويستغفرون لمن في الأرض) أراد به: من المؤمنين لقوله: (وتستغفرون للذين آمنوا)....
3- اُسلوب ظاهر بالخاص يراد به العام:
قال: وأمّا الخاصّ الذي يراد به العامّ فكقوله - جلّ ثناؤه -: (ياأيّها النبي اتّق اللَّه ولا تطع الكافرين والمنافقين)، الخطاب له (صلى الله عليه وآله وسلم) والمراد الناس جميعا.
- تقسيم السيوطي:
وقسّمهما السيوطي في (المزهر) إلى الأقسام التالية:
1- العامّ الباقي على عمومه:
وعرّفه بقوله: ما وضع عامّا واستعمل عامّا ، وأحال في التمثيل له إلى الباب الذي عقده الثعالبي في (فقه اللغة) تحت عنوان (باب الكليّات)، وقد مرّت الإشارة إليه وذكرنا بعض أمثلته.
2- العامّ المخصوص:
وعرّفه بقوله: وهو ما وضع في الأصل عامّا ثمّ خصّ في الإستعمال ببعض أفراده.
ثمّ قال: مثاله عزيز، وقد ذكر ابن دريد: أنّ الحجّ أصله قصدك الشيء وتجريدك له، ثمّ خصّ بقصد البيت.
وعلّق عليه بقوله: فان كان هذا التخصيص من اللغة صلح أن يكون مثالا فيه، وان كان من الشرع لم يصلح، لأنّ الكلام فيما خصّته اللغة لا الشرع.
ثمّ عقبه بقوله: ثمّ رأيت مثالا له في غاية الحسن، وهو لفظ (السبت) فإنّه في اللغة الدهر، ثمّ خصّ في الاستعمال - لغة - بأحد أيّام الاسبوع، وهو فرد من أفراد الدهر.
3- ما وضع في الأصل خاصّا ثمّ استعمل عامّا:
قال: عقد له ابن فارس في فقه اللغة باب (القول في اُصول الأسماء، قيس عليها والحق بها غيرها)، ثمّ قال: كان الأصمعي يقول: أصل (الورد) إتيان الماء، ثمّ صار إتيان كلّ شيء وردا.
4- ما وضع عامّا واستعمل خاصّا ثمّ أفرد لبعض أفراده اسم يخصّه: قال: عقد له الثعالبي في (فقه اللغة) فصلا، فقال: فصل في العموم والخصوص.
ومن أمثلته:
التشهّي عامّ، والوحم للحبلى خاصّ.
الغسل للأشياء عام، والقصارة للثوب خاصّ.
الحديث عامّ، والسمر بالليل خاصّ.
5- ما وضع خاصّا لمعنى خاص:
قال: عقد له ابن فارس في (فقه اللغة) بابا فقال: باب الخصائص.
وأوضحه (أي ابن فارس) بقوله للعرب كلام بألفاظ، تختص به معانٍ لا يجوز نقلها إلى غيرها، تكون في الخير والشرّ، والحسن وغيره.
وفي الليل والنهار، وغير ذلك.
من ذلك قولهم: (مكانك)، قال أهل العلم: هي كلمة وضعت على الوعيد، قال اللَّه - جلّ ثناؤه -: (مكانكم أنتم وشركاؤكم) كأنّه قيل لهم: انتظروا مكانكم حتّى يفصل بينكم.
ومن ذلك: (ظلّ فلان يفعل كذا) إذا فعله نهارا، و (بات يفعل كذا ( إذا فعله ليلا).
هذا كلّه في اللغة العربية من خلال تقسيمات فقهائها.
أمّا في اُصول الفقه فالتقسيمات للعامّ والخاص تنطلق من واقع رؤية الاُصوليين للاُسلوب المستعمل ودلالته على معناها.
ولكنّها في البدايات الاُولى للتدوين الاُصولي نراها تلتقي من حيث العنوان والمحتوى وطريقة العرض أو اُسلوب الطرح بما تقدّم ممّا ذكره علماء فقه اللغة العرب.
ونلمس هذا واضحا في (الرسالة) للإمام الشافعي، فقد جاء فيها:
1- (بيان ما نزل من الكتاب عامّا يراد به العامّ و(لا) يدخله الخصوص:
قال اللَّه - تبارك وتعالى -: (اللَّه خالق كلّ شيء، وهو على كلّ شيء وكيل).
وقال - تبارك وتعالى -: (خلق السموات والأرض).
وقال: (وما من دابة في الأرض إلا على اللَّه رزقها).
فهذا عامّ لا خاص فيه.
قال الشافعي: فكلّ شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فاللَّه خلقه، وكلّ دابة فعلى اللَّه رزقها، ويعلم مستقرّها ومستودعها.
2- بيان ما اُنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العامّ والخاص: قال اللَّه - تبارك وتعالى -: (إنّا خلقناكم من ذكر واُنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أنّ أكرمكم عند اللَّه أتقاكم).
فأمّا العموم منهما ففي قول اللَّه (إنّا خلقناكم من ذكر واُنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا).
فكلّ نفس خوطبت بهذا في زمان رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله وسلم) وقبله، وبعده، مخلوقة من ذكر واُنثى، وكلّها شعوب وقبائل.
والخاص منهما في قول اللَّه: (انّ أكرمكم عند اللَّه أتقاكم) لأنّ التقوى إنّما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم، ودون المغلوبين على عقولهم منهم، والأطفال الذين لم يبلغوا، وعُقِلَ التقوى منهم.
3- بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كلّه الخاص:
وقال: (ياأيّها الناس ضرب مثل فاستعموا له إنّ الذين تدعون من دون اللَّه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب).
قال (الشافعي): فمخرج اللفظ عامّ على الناس كلّهم، وبيّنٌ عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنّه إنّما يراد بهذا اللفظ العامّ المخرج بعض الناس دون بعض لأنّه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون اللَّه إلها - تعالى عمّا يقولون علوّا كبيرا - لأنّ فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم وغير البالغين ممّن لا يدعو معه إلها.
أقسام العامّ:
وبعد هذا العرض العلمي للتقسيم اللغوي، والعرض التاريخي للتقسيم الاُصولي، ننتقل إلى تقسيم العام عند الاُصوليين، بادئين بما يشبه العرض التاريخي، فالملاحظ أنّ تقسيم العامّ في مختصر الشيخ المفيد يأخذ طريقه إلى الاستقرار وفق الرؤية الاُصولية ولكن من حيث العدد.
أمّا من حيث استقرار المصطلح وتعيين عناوينه فهو في الخطوة الاُولى لذلك.
فقد جاء فيه: واعلم أنّ العموم على ثلاثة أضرب:
فضرب: هو أصل الجمع المفيد لاثنين فما زاد.
وذلك لا يكون إلا فيما اختصت عبارة الإثنين به في العدد، فهو عموم من حيث الجمع.
والضرب الثاني: ما عبّر عنه بلفظ الجمع المنكر، كقولك (دراهم) و(دنانير).
فذلك لا يصحّ في أقلّ من ثلاثة.
والضرب الثالث: ما حصل فيه علامة الاستيعاب من التعريف بـ(الألف واللام) وبـ(من) الموضوعة للشرط والجزاء.
فمتى قال (السيّد) لعبده: (عظّم العلماء) فقد وجب عليه تعظيم جميعهم.
وإذا قال: (من دخل داري أكرمته) وجب عليه إكرام جميع الداخلين داره.
فالقسم الأوّل هو ما اصطلح عليه - بعد المفيد - بالعموم المجموعي، والثاني بالعموم البدلي، والثالث بالعموم الاستغراقي، وهي الأقسام الثلاثة للعامّ اُصوليا، إلا أنّها في مختصر المفيد لم تكن بالوضوح المطلوب من حيث التعبير، ولعلّ للإختصار دورا في ذلك.
إذن، فأقسام العامّ في اُصول الفقه الإمامي هي الثلاثة المذكورة:
الاستغراقي والمجموعي والبدلي.
أمّا أساس القسمة فهو كيفيّة تعلّق حكم العامّ بالأفراد وبتعبير أدقّ وأقرب إلى واقع الأقسام الثلاثة المذكورة: هو إمتثال المكلّف، أي: هو جانب التطبيق السلوكي.
1- فالعموم الاستغراقي:
هو الذي تستخدم فيه كلمة (كل) أو ما في معناها بحيث يكون الحكم شاملا لكلّ فرد فرد، فيكون كلّ فرد وحده موضوعا للحكم، ولكل حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاص، نحو (اكرم كلّ عالم.. )(2)، ونحو قوله تعالى: (كلّ الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه)، وقوله: (وقلنا احمل فيها من كلّ زوجين إثنين)، وقوله: (فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كلّ زوجين إثنين).
2- العموم المجموعي:
هو الذي أخذ فيه المجموع - بما هو مجموع - موضوعا للحكم نحو: (اعتقد بإمامة الأئمّة الإثنى عشر)، فانّ وجوب الاعتقاد بإمامة الأئمّة لا يتحقّق إمتثاله إلا بالإيمان بالمجموع.
ومثل قوله (أقيموا الصلاة) فانّ الامتثال - هنا - لا يتحقّق إلا بالإتيان بجميع أجزاء الصلاة، أو قل: الإتيان بالصلاة بصفتها مجموع أجزائها الواجبة.
3- العموم البدلي:
وهو الذي تستخدم فيه كلمة (أي) أو (آية) أو ما في معناهما، ولكن بحيث يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد فقط - على البدل - موضوعا للحكم، فإذا امتثل في واحد سقط التكليف، نحو: (اعتق أيّة رقبة شئت)...(3).
والذي ينبغي أن يكون عليه التقسيم للعامّ بحسب ما له من شمولية أن يقسّم أوّلا إلى قسمين: شمولي وبدلي.
ويقسّم الشمولي إلى: استغراقي ومجموعي.
ذلك أنّ كلا من الاستغراقي والمجموعي يشتركان في شمول الحكم لجميع أفراد العام، بينما البدلي يقتصر فيه على فرد شائع في أفراد العامّ.
فـ(الفرق بين عموم الشمول وعموم البدل):
أنّ عموم الشمول كلّي يحكم فيه على كلّ فرد فرد.
وعموم البدل كلّي من حيث إنّه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كلّ فرد فرد بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل(4).
وحول العموم البدلي أُثير الإشكال بأنّ الشمولية التي هي العنصر الأساسي في تقويم حقيقة العامّ لا تتمثّل فيه، لأنّ الحكم فيه لا يستغرق جميع الأفراد، وإنّما هو لفرد واحد، لكن على نحو البدليّة، فالأحرى إعتباره من نوع المطلق.
واُجيب بأنّ العموم في هذا القسم معناه عموم البدليّة، أي صلاح كلّ فرد لأن يكون متعلّقا للحكم أو موضوعا للحكم(5).
وبأنّ العموم واقع في جهة التطبيق، أي تطبيق المكلّف المأمور به على أفراده التي يدلّ عليها اللفظ مثل: (اكرم أي رجل رأيت)، وليس واقعا في جهة نفس المأمور به الواحد ولا في حكمه.
فجهة العموم هي ما ذكرنا المعبّر عنها بالبدليّة المستفادة من (أي) وتنكير (رجل) في قولنا (أي رجل) فإنّهما يدلّان على صلاحية كلّ فرد لأن يكون موضوع الحكم بدلا من الآخر، وهذا هو المقصود من البدليّة.
وعليه فلا مانع من عدّه في أقسام العموم ولا موجب لدرجه في المطلق(6).
ونحن إذا رجعنا إلى الفارق بين العموم والإطلاق وهو انّ الشمول في الأوّل يستفاد من اللفظ، وفي الثاني من قرينة الحكمة، يكفينا في عدّ هذا القسم من أنواع العموم لأنّ الشمول فيه استفيد من أداة العموم (أي) ومدخولها.
الهوامش:
(1)- موسوعة النحو والصرف والإعراب 62.
(2)- أصول المظفر 1/124.
(3)- م. س 125.
(4)- إرشاد الفحول 200.
(5)- اُصول المظفر 1/125.
(6)- قواعد إستنباط الأحكام 1/268.