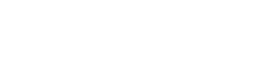محاضرات فقه المجتمع - المحاضرة 33 - موانع الإرث
موانع الإرث
- المبحث الثاني: في موانع الإرث:
وهي كثيرة أنهاها الشهيد الأول (رضوان الله عليه) في الدروس إلى عشرين إلا أن المشهور منها ثلاث بالأصل وهي الكفر والقتل والرق ثم الحقوا بها اللعان والزنا وانفصال الحمل ميتاً والدين المستغرق للتركة والغيبة المنقطعة أما المجموع ثمانية أصلاً وإلحاقاً.
ولا تخفى المسامحة في عدّ اللعان وغيره من موانع الإرث لأنها في الواقع ليست من قبيل المانع وإنما من قبيل عدم المقتضي للإرث.
وكذا ما ذكره في الدروس من العشرين فلعله يعود في جملة منها إلى بعض المسامحات في كونها من الموانع.
ولا يخفى أن المانع قد يكون من أصل الإرث وتمامه ويصطلح عليه حجب الحرمان وفي بعض الأحيان يكون حجباً عن بعض الإرث وهو ما يصطلح عليه بحجب النقصان كما ستعرفه تفصيلاً إن شاء الله.
وكيف كان فإن موانع الإرث كما قلنا في الأصول ثلاثة:
- المانع الأول: الكفر
الأول: هو الكفر والمراد به ما يخرج معتقده عن الإسلام سواءًَ كان بخروجه كافراً حربياً أو ذمياً أو مرتداً أو منتحلاً للإسلام كالخوارج والغلاة.
والفرق بين الأربعة أن الكافر الحربي هو من يحارب الإسلام والمسلمين والكافر الذمي من دخل في المجتمع الإسلامي بعهود الذمة والمقصود بالمرتد من كان مسلماً ثم كفر أو كان كافراً ثم أسلم ثم كفر على التفاصيل التي ستعرفها فيما بعد:
أما المنتحل للإسلام فهي الطوائف التي غالت فخرجت بذلك عن ربقة الإسلام كالخوارج والغلاة وكيف كان فإن الكفر بأصنافه مانع من الإرث أصلياً كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر المسلم ولا من في حكم وإن كان قريباً إجماعاً ونصوصاً متواترة فعن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) (لا يتوارث أهل ملتين قال نرثهم ولا يرثونا إن الإسلام لم يزده إلا عزاً في حقه).
وفي معتبرة عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) (في النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال نعم إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزاً فنحن نرثهم وهم لا يرثونا).
وعنه (عليه السلام) أيضاً عن محمد بن قيس قال (سمعته يقول لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى).
وعن الصادق (عليه السلام) في معتبرة أبي خديجة (لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء).
إلى غير ذلك من الروايات فإن الكافر لا يرث المسلم ولكن يختص المسلم بإرث الكافر وإن كان المسلم بعيداً إجماعاً ونصوصاً عرفت بعضها وبعضها ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) (لو أن رجلاً ذمياً أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ما له ولم يرثه ولده ولا زوجته مع المسلم شيئاً).
إلى غير ذلك من الروايات وعليه فلو كان للميت ولد كافر وله ابن ولد مسلم يرثه ابن الولد لا الولد وكذا لو كان له ابن كافر وأخ وعم وابن عم مسلم ورثه المسلم دونه مع أن ابن العم والعم والأخ في طبقة ثانية لا في طبقة الولد.
غير أن الكفر منع من إرث الولد فيصل الإرث إلى المسلمين ولو كانوا في الطبقات الأخرى.
وكذا لو لم يكن للميت وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص ارثه به على الترتيب دون الولد الكافر.
وإذا لم يكن للميت في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم يكون موضوعاً ممن لا وارث له فحينئذٍ يختص إرثه بالإمام (عليه السلام) ولم يرث أبوه الكافر منه شيئاً.
وكذا في القاتل كما ستعرفه.
ولو لم يكن للمسلم إلا الكفار لم يرثوه وورثه الإمام (عليه السلام) للإجماع ولما يأتي من أن الإمام (عليه السلام) وارث من لا وارث له.
وعليه فالكافر لا يرث المسلم ولو كان قريبا والمسلم يرث الكافر وإن كان بعيداً أصلياً كان أو لا إجماعاً ونصوصاً من غير فرق بين أصناف الكفر ففي معتبرة سماعة (قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المسلم يرث المسلم؟ قال نعم ولا يرث المشرك المسلم).
و في رواية أبي الأسود الدؤلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا يهودي مات وترك أخاً مسلماً فقال معاذ سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول (الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم من أخيه اليهودي).
إلى غير ذلك من الراويات بل أن ذلك موافق للاعتبار أيضاً لأن الله عز وجل إنما منع الكافر من ميراث المسلم عقوبة لحيثية كفره وجحوده كما منع القاتل عن الميراث عقوبة لقتله فلو كان الوارث مسلماً فلا يجري فيه تلك الحيثية فلا مانع من إرثه من أقربائه الكفرة إذا لم يكن مانع آخر في البين.
وكما يستفاد ذلك من قوله (صلى الله عليه وآله) (الإسلام يزيد ولا ينقص) وقوله (عليه السلام) (ان الإسلام لم يزده إلا عزاً في حقه).
- مسائل وتفريعات:
وهنا مسائل:
المسألة الأولى: لو مات الكافر وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم سواءً كان بعيداً أو قريباً وإن لم يكن له وارث مسلم وهو كافر وورثته كفار يرثونه على القواعد عندهم إجماعاً ونصوصاً ففي صحيح ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) (في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال (عليه السلام) هم على مواريثهم). وغير ذلك من الروايات.
- في توارث الكفار:
ثم أن الميراث بين الكفار إنما يكون وفق دينهم ومذهبهم لما عرفته من الرواية التي تنص على إنهم على مواريثهم ولقوله (عليه السلام) (أن كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه).
ولما بيناه سابقاً من قاعدة الإلزام المستفادة من أمثال هذه الرواية مضافاً إلى ظهور الإجماع.
وعليه فإنه يظهران ما يستفاد من بعض الأخبار من أن الميراث بين الكفار إنما هو على حسب كتاب الله تعالى وسنة نبيه لا على ما يدينون به كرواية أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) (قال أن علياً (عليه السلام) كان يقضي في الموارث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركة لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء وللرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه).
وقريب منه صحيح محمد بن قيس عنه (عليه السلام) أيضاً.
ولا يخفى امكان قراءة هذا النص بشكل آخر.
وعلى أي حال فإن مثل هذه الروايات الدالة على أن الإمام (عليه السلام) كان يقسم أموال المشركين على كتاب الله وسنة نبيه ولم يأخذهم بقانون الإلزام فيحمل على أحد وجوه:
الأول: أن يكون لهؤلاء الناس من المشركين رضا بتقسيم الإمام بمعنى أنهم أوكلوه (عليه السلام) في التقسيم وحينئذٍ ينبغي التقسيم على حسب مقتضيات الحكم الواقعي.
الثاني: أن نقول كما ربما يظهر من متن الرواية من قوله (لم يكن قسم قبل الإسلام) بمعنى أنه لم يكن تقسيم قبل الإسلام لهم وبما أنهم ما كانوا يعرفون التقسيم بمعنى أنه لا يوجد عندهم ضابطة أو قانون خاص في تقسيم الإرث فمقتضى القاعدة حينئذٍ هو التقسيم بحسب موازين الإسلام لأنها الموازين الواقعية.
الثالث: أن نحمله على أن هذا الحكم كان في عصر خلافته الظاهرية لمصلحة يراها لا لحكم الله الواقعي في كل عصر بعبارة أخرى كان تقسيم الإمام (عليه السلام) في هذه الصورة تقسيماً وقتياً لا دائمياً لقضية خاصة أو مصلحة خاصة فيكون تقسيم الإمام عليه السلام ولائياً لا حكماً شرعياً.
هذا بالنسبة لحكم الكافر غير الذمي.
وأما الكافر الذمي فكيفية الميراث بالنسبة إليه تتبع الشروط المأخوذة عليهم في عهد الذمة فقد يتم التوافق بين المسلمين وبينهم على أن يكون التقسيم على حساب كتاب الله تعالى والسنة الشريفة.
وعلى هذا ينبغي التقسيم على ما اتفقوا عليه.
وقد يكون الاتفاق على أن يكون التقسيم بحسب دينهم فحينئذٍ ينبغي التقسيم على حسب دينهم وهكذا.
- أقسام الكفار وكيفية التقسيم:
وكيف كان فإن المجموع الحاصل بالنسبة إلى الكفار هو أربعة أقسام:
الأول: الوارث والمورث كلاهما حربيان وحينئذٍ فإن ماله ونفسه تكون للإمام (عليه السلام) يتخير هو ما يشاء وإن كان الحاكم يراعي المصلحة في ذلك ويقدم الأهم في البين، وإن لم يرجع إلى الحاكم والإمام (عليه السلام) فهم يرثون بينهم بحسب عقيدتهم.
الثاني: أن يكون الوارث والمورث كلاهما ذميان والتقسيم بينهم راجع لشروط عقد الذمة.
الثالث: أن يكونا ذميين ولكن لم يشترط لكيفية الإرث في عقد الذمة شرط خاص فحينئذٍ تشمله إطلاق قانون الإلزام وإطلاق قوله (عليه السلام) (هم على ميراثهم) فيقسمون إرثهم على حسب ما يعتقدون .
الرابع: لو شككنا في تحقق الشرط وشككنا في أن هذا الميت ذمي أو غير ذمي وكذا الوارث أنه ذمي أم لا ؟ فحينئذٍ نرجع إلى قانون الإلزام أيضاً عملاً باطلاقات أدلته.
- إرث المرتد بنوعيه:
ويستثنى من ذلك الكافر المرتد سواءً كان مرتداً فطرياً أو مرتداً ملياً فإن ميراثه حينئذٍ للإمام (عليه السلام) دون ورثته الكفار إجماعاً فتوى وعملاً.
والمقصود من المرتد هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر بعد ما كان مسلماً.
وهو على قسمين: مرتد فطري ومرتد ملي.
أما الأول: فهو من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثم أظهر الإسلام بعد بلوغه ثم خرج عن الإسلام.
والثاني: من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته وولد على ذلك واستمر على الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصلياً ثم أسلم بعد البلوغ ثم عاد إلى الكفر كنصراني أسلم ثم عاد إلى نصرانيته فإنه يقال له مرتد ملي، ولكل واحد من المرتدين أحكام خاصة سنتعرض إليها فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
وكيف كان فإن المرتد الفطري أو الملي لا يرثه ورثته الكفار ، وكأن المرتد الميت لا وارث له لو كان ولده جميعاً كفاراً وعليه فلا تصل النوبة حينئذٍ إلى عمومات الإرث ويستفاد ذلك من مفهوم قول الصادق (عليه السلام) في معتبرة أبان (في رجل يموت مرتداً عن الإسلام وله أولاد؟ فقال (عليه السلام) أمواله لولده المسلمين).
فإنه مطابق للقاعدة بناءً على ما اخترناه فيكون حجة.
وما يظهر من إطلاق بعض الأخبار كصحيح محمد بن مسلم (قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد؟ فقال من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وبانت امرأته منه فيقسم ما ترك على ولده) تحمل على أن ولده مسلمون أو يحمل على اذن الإمام (عليه السلام) في تقسيم ميراثه على أولاده الكفار لمصلحة يراها من الأهم والمهم ونحوها.
ثم إنه في زمان الحضور يكون الميراث للإمام (عليه السلام) وأما في عصر الغيبة فإن قلنا أنه ملك شخصي للإمام (عليه السلام) كما ربما يستفاد ذلك من مثل قولهم (عليه السلام) (الإمام وارث من لا وارث له) أو يكون من قبيل الأنفال المختصة به (عليه السلام) وشمل عموم الولاية ذلك فيرجع في ذلك بعده إلى نائبه وهو الحاكم الشرعي الجامع للشرائط أي المرجع الجامع للشرائط أيضاً.
وأما إذا قلنا بعدم ملكه (عليه السلام) لذلك بل هو من قبيل الصدقات يكون لعامة المسلمين فيصرفها الإمام (عليه السلام) في مصالحهم فحينئذٍ يأخذه الحاكم الشرعي ويصرفه في المصالح العامة أيضاً كسائر الصدقات.
وإن قلنا بعدم العموم في الولاية أو شككنا في ذلك فيمكن أن يكون داخلاً في الحسبة التي للحاكم الشرعي التصدي لها على أي تقدير.
وعليه فإن المرتد إذا ترك أولاداً أو ورثة كفاراً فلا إرث لهم ولو كان له وارث مسلم كان الميراث للمسلم سواء كان معه من ورثته من الكفار أو لم يكن، قرب هذا المسلم منه أم بعد، كما عرفت وجهه.
ولا فرق في المسلم بين الكبير والصغير كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه أو أحدهما فإنه مسلم إجماعاً لما مرّ من أن الولد يتبع اشرف الأبوين.
لو لم يكن وارث مسلم إلا الزوج:
ثم أنه لو كان الميت مرتداً ولم يكن له وارث إلا الزوج المسلم كان تمام الميراث له ولا يصل إلى الإمام (عليه السلام) لأنه وارثه المسلم بالفرض والرد كما مرّ.
وأما لو كان وارثه زوجته المسلمة يكون ربع الميراث لها للنص والبقية للإمام (عليه السلام) لما تقدم من عدم الرد بالنسبة إليها وإن لها الفرض فقط.
وأما إذا لم يكن له وارث مطلقاً أو كان ورثته جميعاً كفاراً كان إرثه للإمام (عليه السلام) على ما بيناه.
كما أنه لو مات المسلم وكان جميع وراثه كفاراً لم يرثوه وكان وارثه الإمام (عليه السلام) للملاكات التي بيناها.
- لو أسلم الوارث الكافر:
المسألة الثانية: لو كان للميت وارث مسلم وآخر كافر وأسلم وارثه الكافر شارك الورثة في الإرث وذلك بشروط:
الأول: أن يكون إسلامه قبل قسمة التركة إجماعاً ونصوصاً خاصة في المقام في صحيح محمد ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يسلم على الميراث؟ قال إن كان قسم فلا حق له وإن كان لم يقسم فله الميراث).
إلى غير ذلك من الروايات بل ذلك مقتضى الاعتبار أيضاً لأنه بعد القسمة وانتقال المال إلى الورثة فإنه لا موضوع للتركة حينئذٍ حتى يشارك فيها وحينئذٍ لا ينفع إسلامه في خصوص الإرث فقط لا باقي الأحكام.
الثاني: التساوي في المرتبة اختص بالإرث حينئذ وحجب الورثة عن الإرث إن تقدم عليهم في الرتبة لما بيناه من أن الإرث بحسب المراتب فلا تصل النوبة إلى مرتبة إلا بعد انتفاء المرتبة السابقة فلو كان من أسلم ابناً للميت وهم أخوته تقدمهم وحجبهم ولو كان منفرداً في المرتبة السابقة يختص بجميع الإرث.
نعم لو كان الوارث واحداً وهو الزوجة فحينئذٍ لو أسلمت قبل قسمة الإرث قسم بينها وبين الإمام (عليه السلام) لأنه لها الفرض دون الردّ وإلا فلا شيء لها.
الثالث: أن لا يكون هناك مانع آخر عن الإرث كالقتل والرق فإن أسلم لا يشركه في التركة حينئذٍ لوجود المانع الآخر.
الرابع: أن يكون إسلامهم في وقت واحد إن تعددوا فلو سبق أحدهم بالإسلام ولحقه الآخر اختص السابق بالإرث إن انحصرت التركة بينهم وذلك لعدم الموضوع في اللاحق حينئذٍ وعليه فإنه يعتبر التساوي في المرتبة وفي الإسلام.
- المسلمون يتوارثون ولو اختلفت مذاهبهم:
المسألة الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد لما تقدم من العمومات الدالة على التوارث كتاباً وسنة مضافاً إلى النصوص الكثيرة الدالة على ذلك أيضاً منها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان (يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته ومثله غيره) مضافاً إلى الإجماع فيرث المحق منهم عن غيره ومبطلهم عن مثله.
نعم يخرج من ذلك المحكومون منهم بالكفر كالغلاة والخوارج والنواصب للعمومات الدالة على منع الكافر عن إرث المسلم سواءً كان من الكفار موضوعاً كالمشركين أو كالكفار حكماً كالغلاة.
ومضافاً إلى الإجماع حيث حكم الفقهاء بكفرهم لأنهم يحجدون ما ثبت ضروريته في الدين.
وعليه فإن من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كوجوب الصلاة المفروضة وصوم شهر رمضان والحج مع الإلتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة فهو كافر كما فصله الفقهاء في كتاب الطهارة.
وحينئذٍ يرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه لما بيناه من أن الكفر المانع من الإرث أعم من الموضوعية والحكمي لكن إذا شككنا في فرقة المسلمين وترددنا في أنهم محكومون بالكفر فلا يرثون أولا فيرثون فإنه في هذه الصورة يعمل بالأصل الموضوعي ومع عدمه يرجع إلى الأصل الحكمي وهو أصالة عدم موجب الكفر فحينئذٍ نحكم بأنهم يرثون.
نعم ينبغي إحراز أن من أنكر الضرورة من الدين أنكرها عمداً وعصياناً ولم ينكرها عن شبهة فكرية أو اعتقادية حصلت له وإلا فإن الفقهاء يصرّحون بأن منكر الضروري أن رجع إلى الكفر بأن لم يكن عن شبهة وكان راجعاً إلى إنكار نبوة النبي (صلى الله عليه وآله) أو الألوهية أو المعاد المشترطة في الإسلام لم يتوارث وإلا كما لو كانت هناك شبهة فكرية أو اعتقادية أو ما أشبه ذلك حصلت له فحينئذٍ لا يصلح ذلك أن يكون مانعاً عن الإرث.
ولذا قال في المستند (لو لزم من إنكاره إنكار صاحب الدين ورجع إليه بأن لم يحتمل الشبهة في حقه يمنع من إرثه).
وحينئذٍ فإنه لا يكفي صدق الإنكار للضروري في منع الإرث وإنما إنكار الضرورة إنما تترتب عليها أحكامها في الكفر والحرمان عن الإرث وأمثال ذلك إذا لم تكن عن شبهة وأما إذا كانت عن شبهة فقد صرح الفقهاء بأنه يتوارث ولذا صرح شيخنا المفيد رضوان الله عليه في إحدى نسختي المقنعة ( فإن اختلاف المسلمين في الآراء والأهواء لا يمنع من توريثهم ) وأضاف في الجواهر على الأدلة الثلاثة ـ أي الكتاب والسنة والإجماع أضاف شهادة تتبع أقوال السلف من توريث المسلمين بعضهم من بعض في جميع الأعصار مع الفتوى الظاهرة والشهرة المعلومة.
أضاف سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه بأن الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حصنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وظهور أن النفاق أسوء من الخلاف حيث أن الأول لا يعتقد حتى بالله وإنما يجري به لقلقة لسان لحقن دمه أو لا يعتقد بالرسول (صلى الله عليه وآله) أو المعاد ومع ذلك كان أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) يرث بعضهم بعضاً مع النفاق الذي كان موجوداً في جماعة منهم مما يظهر منه صحة الإرث والاكتفاء بالمواريث على الإسلام دون الإيمان خرج من ذلك منكر الضروري على ما بيناه من تفاصيل.
- أحكام المرتد:
المسألة الرابعة: في الأحكام المتعلقة بالمرتد أما المرتد الفطري فإن كان رجلاً تبين منه زوجته بالارتداد بغير طلاق وتعتد منه عدة الوفاة. ثم يجوز لها أن تتزوج بالغير إن ارادت ذلك وتقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت ولا ينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه للإسلام في رجوع زوجته إليه إجماعاً ونصوصاً كما في صحيح محمد بن مسلم (قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده).
إلى غير ذلك من الروايات.
نعم تقبل توبته باطناً بل ظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام فيطهر بدنه وتصح عباداته ويملك أمواله الجديدة بأسبابه الاختيارية كالتجارة والحيازة وكذا القهرية كالإرث كما يجوز له التزويج بالمسلمة بل له تجديد العقد على الزوجة السابقة وإن كان المرتد امرأة تبقى أموالها على ملكها ولا تنتقل إلى ورثتها للأصل بعد عدم الدليل على الانتقال.
نعم إذا ماتت تنتقل إلى ورثتها.
كما أن المرأة المرتدة تبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد أن كانت غير مدخول بها لما تقدم في بحث الطلاق من أنه لاعدة لغير المدخول بها إلا في الوفاة سواء كان الافتراق بالطلاق أو بالانفساخ.
- الارتداد سبب للانفساخ.
وأما مع الدخول بها فينفسخ نكاحها لكن عليها عدة الطلاق حينئذٍ إجماعاً ونصوصاً فإن تابت وهي في العدة عادت إلى الزوجية لتوقف حصول الانفساخ على انقضاء العدة وإن الرجوع إلى الزوجية بالإسلام قهري كما بينه الفقهاء في كتاب النكاح وأما إذا لم تتب إلى أن انتهت العدة بانت من زوجها نصوصاً وإجماعاً هذا بالنسبة إلى الكافر الفطري.
وأما الكافر الملي سواءً كان رجلاً أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت للأصل وعدم الدليل على الانتقال إلا بسبب شرعي اختياري أو قهري وينفسخ النكاح بين المرتد وزوجته المسلمة وكذا بين المرتدة وزوجها المسلم بمجرد الارتداد مع عدم الدخول ومع الدخول تعقد عدة الطلاق من حين الارتداد إجماعاً ونصوصاً فإن تاب المرتد أو تابت المرتدة قبل انقضاء العدة عادت الزوجية وإلا فلا.
- تنبهات في أحكام المرتد.. قتل المرتد:
وهنا أمور مهمة ينبغي التنبيه عليها في هذه المسألة:
الأمر الأول: أن قتل المرتد عن فطرة وتقسيم تركته وبينونة زوجته لا اشكال فيها ولا خلاف وكل ذلك من قبيل الحد ، كما أن قاطع الطريق يقتل وذلك لصحيح محمد بن مسلم المتقدم لكن هذه الأحكام الثلاثة يلزم أن تترتب إذا لم يكن ارتداده عن شبهة كشبهة فكرية أو شبهة في العقيدة أو ما أشبه ذلك وإلا فقد ذكر العلامة الحلي (رضوان الله عليه) وصاحب الجواهر وتبعهم جمع من الفقهاء المعاصرين منهم سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه عدم جريان الأحكام فيما إذا كانت هنالك شبهة كما فصلوه في كتاب الحدود.
وبما أن هذه الأحكام تترتب إذا لم يكن الارتداد عن فتنة عامة وإلا فلا تترتب كما بينوه أيضاً في كتاب الجهاد.
ويؤيده ما رواه شرح الأخبار كما في المستدرك في باب حكم سبي أهل البغي من أن موسى بن طلحة الذي أسره الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في يوم الجمل أخرج إلى علي (عليه السلام) من السجن فقال الإمام (عليه السلام) له قل استغفر الله وأتوب إليه ثلاث مرات فقال (عليه السلام) لأنصاره خلّوا عنه... إلى آخر الحديث) مع أن محاربة الإمام (عليه السلام) ارتداد بلا شك فإن محاربي الإمام (عليه السلام) كفرة حيث قال (صلى الله عليه وآله) (حربك حربي).
مضافاً إلى تصريح القرآن بأنهم بغاة في قوله سبحانه وتعالى: ((وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ)).وبلا شك فإن الإمام (عليه السلام) كان هو إمام الزمان والذين قاتلوه قد خرجوا عنه ومع أن موسى ابن طلحة ولد في الإسلام لا في الكفر وقاتله إلا أنه (عليه السلام) خلى سبيله وذلك لحصول الشبهة في المقام.
وعليه فإذا ارتد بدون شبهة ولم يتب ترتبت عليه الأحكام الثلاثة وإن لم يقتل ترتب عليه الحكمان الآخران فحينئذٍ تحرم عليه زوجته وتقسم أمواله على ورثته.
وأما إن كان ارتداده عن شبهة أو تاب لم يقتل وأما الحكام الآخران فإنهما كما ذكروا في المرتد الملي على نحو ما قاله المحقق الحلي رضوان الله عليه في الشرائع. حيث قال (ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب فإن تاب وإن قتل ولا تقسم أمواله حتى يقتل أو يموت فتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما فإن تاب قبل خروجها من العدة فهو أحق بها وإن خرجت العدة ولم يتب فلا سبيل له عليها).
أما الاستتابة فقد عرفت وجهها بالأدلة العامة والخاصة والتي منها خصوصاً توقيع مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عامله (أما من كان من المسلمين فولد على الفطرة فاضرب عنقه).
والظاهر أن عدم الاستتابة في الفطري نوع تهديد وتخويف مثل قوله تعالى: ((أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ)) مع أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يشدد عليهم إلا باللفظ وما أشبه في قليل من الأحيان لمصالح خاصة ولعل الإمام علي (عليه السلام) أمر بالقتل في تلك القضية من باب قضية في واقعة حيث أن زمانه كان زمن اضطرابات خلفها بعض من سبقه في الأمة.
- الحكم بالقتل:
الأمر الثاني: بالنسبة إلى الحكم بالقتل إذا لم يتب فقد عرفت أنه إنما يقتل إذا لم يكن ارتداده عن شبهة وإلا لم يقتل فإن أدلة القتل منصرفة إلى ما كان الارتداد عن عناد وإصرار لا عن شبهة كقوله تعالى: ((وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ)) وأما بالنسبة إلى عدم تقسيم ما له حتى يقتل أو يموت بل في الجواهر وإن التحق بدار الحرب والظاهر أنه إذا التحق بدار الحرب صار ماله كالحربي مباحاً للمسلمين فللإسلام أن يصادر ماله سواء مات أو لم يمت وعليه فلبعض أولاده الاستيلاء على ماله بإذن الإمام (عليه السلام) سواء كان حياً أو ميتاً.
وكيف كان فعدم تقسيم ماله قبل زهوق روحه لعدم الدليل على التقسيم المذكور فحينئذٍ يكون الأصل بقاء ماله لنفسه وقد نقل الخلاف في ذلك بتقسيم ماله عن النهاية والمهذب فيورث وإن كان حياً وعلل أنه صار بوجوب القتل كالفطري.
وربما أيد ذلك بصحيح الحضرمي حيث أطلق ترتيب القتل وبينونة المرأة فالتقديم مثلهما لكن لا يخفى ما في كلا الوجهين من نظر ولذا قال الجواهر: (إن كونه كالفطري ضعيف وقد رجع عنه الشيخ كما قيل).
- إذا تاب المرتد:
الأمر الثالث: إذا تاب المرتد عن فطرة ولم يقتل ولو لعدم بسط يد الحاكم الشرعي جاز له أن يتزوج بنفس الزوجة لما عرفت من قبول توبته وإن القتل من باب الحد، هذا بالنسبة إلى الزوجة الدائمة وأما الزوجة المتمتع بها فمقتضى كلامهم أن عدتها تكون عدة الوفاة بالنسبة للفطري مطلقاً وعدم وجوب عدة الطلاق إذا لم تكن مدخولاً بها أو كانت صغيرة أو يائسة في الارتداد الملي لأن العدة عدة طلاق.
- المانع الثاني: القتل:
المانع الثاني من الإرث: وهو القتل إذ لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً إجماعاً ونصوصاً فعن نبينا الأعظم (صلى الله عليه وآله) في الصحيح أنه قال: (لا ميراث للقاتل).
وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في صحيح أبي عبيدة: (في رجل قتل أمه، قال لا يرثها ويقتل بها صاغراً ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه) إلى غير ذلك من الروايات.
ولا يخفى أن هذا ما يقتضيه العقل أيضاً إذ لولاه لم يؤمن مستعجل الإرث غير المبالي بدينه أن يقتل مورثه ولا فرق في القاتل أن يكون قريباً أو بعيداً مادام يرث من المقتول.
وعليه فإن القاتل يمنع من الإرث ويرث منه لو كان القتل بحق ولو كان عمداً إجماعاً ونصوصاً.
منها العمومات والاطلاقات الدالة على الإرث.
ومنها رواية جعفر بن غياث: (في طائفة من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي أيرثه؟ قال نعم لأنه قتل بحق) والتعليل في هذه الرواية عام يشمل كل مورد كان القتل بحق ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو المباشر للقتل أو كان سبباً للقتل ، والقتل بالحق يشمل القصاص أيضاً والحد والدفاع عن العرض والمال كما بينه الفقهاء في باب الحدود والديات.
وكيف كان فإن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله له عمداً وظلماً.
ويرث منه لو كان قتله بحق ولو كان عمداً سواء جاز للقاتل تركه أو لا للاطلاق ولما مرّ في رواية حفص.
ولو كان القتل خطأ محضاً كما لو رمى طائراً فأخطأ وأصاب من يرث منه وكذا لو ضرب الوالد ولده تأديباً فمات وكذا لو فتق جرحاً للإصلاح بعد الأذن منه إذا كان من الورثة مثلاً وما أشبه ذلك فإنه في صورة القتل الخطئي يرثه ولا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة.
أما الأول فعلى المشهور نصوصاً وإجماعاً ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها وإن قتلها متعمداً فلا يرثها).
ومثله صحيح عبد الله بن سنان وحديث (رفع المؤاخذة عن الخطأ) الى غير ذلك من الروايات وأما في تحمل الدية عن العاقلة فلما بينه الفقهاء في باب الديات، من أن الدية في قتل الخطأ المحض على العاقلة إن توفرت الشرائط.
وأما القتل شبه العمدي فهو ملحق بالخطأ أيضاً.
والمقصود من القتل شبه العمدي وهو فيما إذا كان قاصداً لايقاع الفعل على المقتول ولكنه غير قاصد للقتل.
وإن الفعل الذي يفعله مما لا يترتب عليه القتل عادة كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب فتحقق قتله كما بينه الفقهاء في كتاب الديات.
أما أنه ملحق بالخطأ فلعمومات أدلة الإرث خرج منها صورة العمد قطعاً وباقي الصور كصورة الخطأ وشبه العمد فهي مشكوكة الخروج فالمرجع فيها هو العموم وأصالة عدم التخصيص.
مضافاً إلى أن المنصرف من قولهم (القاتل لا يرث) هو صورة العمد والاجتراء.
أما صورة الخطأ وشبه العمد فهو خارج حسب ما يفهمه العرف من أمثال هذه الأدلة.
وهنا مسائل:
- مسائل وتفريعات:
المسألة الأولى: عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ نصوصاً منها (عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة) ويلحق به النائم والساقط من غير اختيار لعدم القصد إلى الفعل فكيف إلى القتل مضافاً إلى الإجماع والنص فعن علي (عليه السلام) (رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ).
وكذا يلحق بهم السكران لو كان بحق وفي غيره بحكم العمد كما تقدم تفصيلاً.
ولا فرق في القتل العمدي المانع عن الإرث بين ما إذا كانت بالمباشرة كما لو رماه باطلاق ناري أو رماه بسهم أو ما أشبه ذلك وبين ما إذا كان بالتسبيب كما إذا حبسه في مكان زماناً طويلاً فمات من الجوع أو شرّده في صحراء باردة فمات من البرد أو رماه في نهر أو بحر فمات غرقاً أو أحضر عنده طعاماً مسموماً ولم يعلم المقتول به فأكله إلى غير ذلك من التسبيبات التي يستند القتل فيها إلى المسبب عرفاً كل ذلك تسبيباً أو ليس بتسبيب كما إذا حفر بئراً في داره مثلاً فجاء شخص ووقع فيها أو وضع المزالق وقشور الفاكهة في الطريق من غير قصد للتلف وما أشبه ذلك فمر عليها شخص فسقط، و مرّ به وارثه صدفة فتلف أيضاً فالظاهر أن أدلة الإرث من الاطلاقات والعمومات لا تمنع من شموله وإن أوجب ذلك الفعل الضمان والدية كما ذكره الفقهاء في كتابي الغصب والديات لأن هذا لا يصدق عليه أنه قتل عمدي.
- القاتل الواحد والمتعدد:
المسألة الثانية: لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدداً للاطلاق بالأدلة كما لا فرق بين أن يكون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض فيلحق بكل ذلك حكمه كما يستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب للعمومات والاطلاقات مضافاً إلى الإجماع.
المانع الثالث: الرق
المانع الثالث من الإرث: هو الرق.
والصور فيه ثلاثة:
إحداها: كون الوارث والمورِّث كلاهما رقاً ولا اشكال بعدم الإرث بينهما للأدلة الخاصة التي تقول بأن العبد لا يرث والطليق لا يورث العبد وما في معتبرة محمد بن حمدان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لا يتوارث الحر والمملوك).
ثانيها: لو كان المورِّث حراً والوارث رقاً ولا اشكال في عدم الإرث أيضاً إلا أن يعتق المملوك ويصير حراً.
ثالثها: كون المورِّث رقاً والوارث حراً ولا اشكال في عدم الإرث أيضاً بل ينتقل المال إلى السيد على تفصيلات بينها الفقهاء في باب الإرث وفي باب العتق وحيث أن هذه المسألة خارجة عن محل ابتلاء الناس في هذه الأزمنة تتركها إلى المفصلات من الكتب الفقهية.